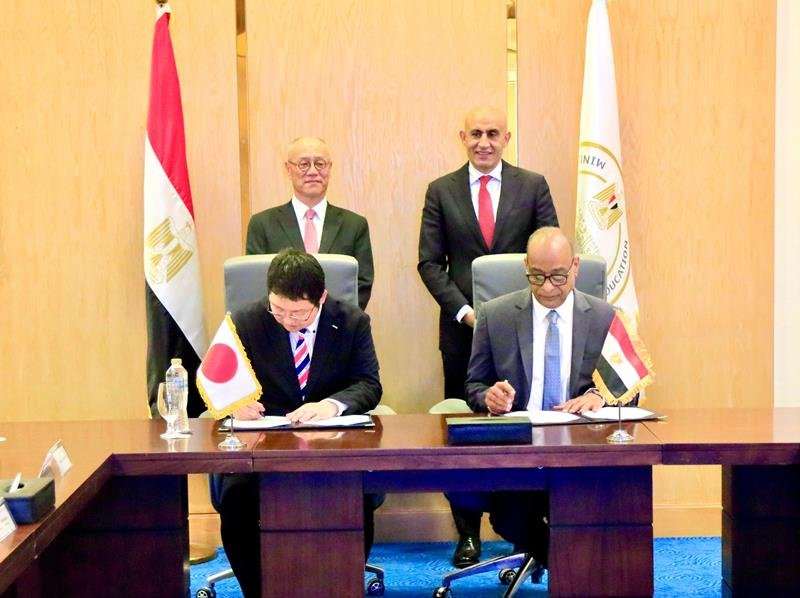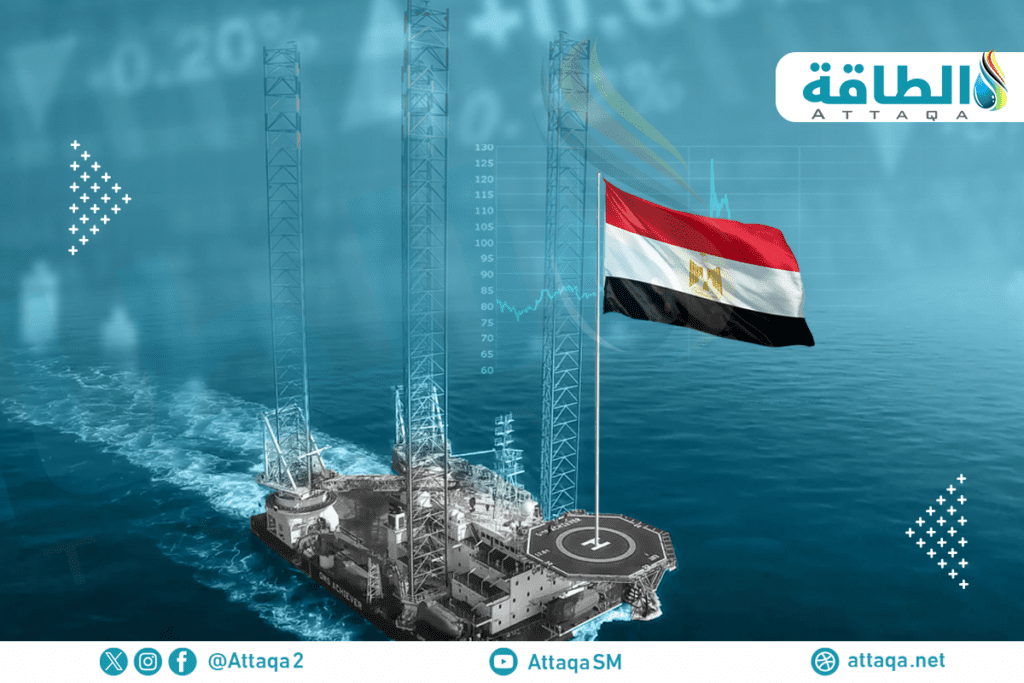بقلم دكتورة / أماني فؤاد
توارثت مجتمعاتنا وثقافتنا وصية امرأة أعرابية، تُدعَى (أُمامة بنت الحارث)، توصي ابنتها، بعشْر خصال قبْل الزواج، وأتذكر أنها كانت ضمن النصوص التي درسناها في المرحلة الثانوية، قالت الأم في نصائحها: “كوني له أمَةً؛ يكُن لك عبدًا، الخضوع له بالقناعة وحُسن السمع والطاعة، لا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشمّْ منك إلا أطيب ريح، التفقد لوقت منامه وطعامه، وحفْظ ماله ورعاية عياله، لا تعصي له أمرًا، ولا تُفشي له سِرًّا، وإياكِ والفرح بين يدَيه إن كان مغتمًّا، والكآبة بين يدَيه إن كان فرِحًا”.
ماذا لو تأمَّلنا في 2025 هذه الوصايا والخصال، التي تدعو الأم ابنتها للتحلِّي بها، لتجربة زواج ناجح، ماذا لو انطلقنا بها من مساحات أخرى، من قِيَم ومعانٍ ودلالات أكثر إنسانية ومعاصَرة، مساحات تليق بعلاقة حقيقية ناضجة بين المرأة والرجُل؟
وأود الإشارة إلى أنه من المدهش لديَّ أن يدافع الكثير من الرجال والنساء عمَّا وَرَد في هذه الوصية، باعتباره سيكفُل علاقة مريحة بين الزوج والزوجة، بالرغم من تاريخية هذا النَّص، وأن هذه المقاييس في العلاقة لا يمكن أن نتقبَّلها إلا ضمن مقتضيات ثقافة امرأة عاشت منذ قرْن ونِصف.
وهنا تنطلق مجموعة من الأسئلة، أودُّ طرْحها مع القراء: هل منطقة العبودية – المرأة الأَمَة أيْ الجارية، والرجُل العبد – هي المساحة الأنسب لوصف العلاقة بين الزوج والزوجة!؟ أحسَبُ هوانَ وهشاشة هذه المنطقة، لو أردنا التمتع بعلاقة ناضجة بين زوجين أو حبيبين، فحتى بافتراض أن الأعرابية استخدمت مجرد تعبير مجازي؛ علينا تسويد هذه المنطقة تمامًا، ومحوها، ففي مساحات أخرى تمامًا تنمو علاقة الزواج، حيث مظلة شاملة من الحب، الذي لا يشوبه رغبات السيطرة ولا تحكُّم طرف بآخَر، فالقدرة على التواصل، والاستماع إلى الطرف الآخَر، والصداقة، مقومات أساسية لتفتُّح علاقة الرجُل بالمرأة، والمرأة بالرجُل، واستمرارها، لا مساحات العبودية، وفرْض الرأي، والانفراد بالقرار، فتلك المساحات الأخيرة لا يتوالد فيها إلا رغبات الانتقام من الطرف المستضعَف، والعيش كرهًا.


وأعني – في المساحات التي أقصدها – سيادة المحبة، التي تترك مساحات الود اللطيف والتفاهم الحُر، منطقة تحتضن قيمَتَي الرعاية والاحتواء، عكس العبودية والانصياع تمامًا، نستهدف مناطق التلاقي الحقيقي، التي لا يخشى فيها طرف من آخَر، بل يحافظ كل منهما على اختيارات الآخَر، يشجعه، ويساعده على أن يحقق كلٌّ منهما ذاته، ويقبض على حلمه.
ولعلنا هنا نتساءل في ظِل تطورات حياة المرأة وتعليمها وعملها، وإمكانية كفايتها المادية لنفسها، وعدم الاحتياج المباشر لرعاية الزوج بصور الدعم المختلفة، حيث تتزايد هذه الحالات كل يوم بين النساء هروبًا من تحكمات الزوج، ومعايير وعي جمعي مجتمعي عام، تضع المرأة في مكانة التابع المتحكَّم فيه، هل يمكن في ظِل تطورات المرأة وقدرتها على الاستقلال أن تستغني عن الرجُل؟ أم أن عطاء الرجُل للمرأة، والمرأة للرجُل يظَل جميلًا، يهَب مذاقًا للحياة وشغفًا، يحقق لهما معًا دعمًا وسعادة. حالة احتضان أفضل كثيرًا مما لو كان كل فرد منهما بمفرده، تستطيب المرأة أن يشملها الرجُل بعطائه وكَرَمه، بحَدَبه عليها، مهما امتلكت واكتفت، كما أن طبيعة الاحتواء والعطاء تُشعر الرجُل بخصائصه الفطرية الطبيعية، فيسعد ويشمل المرأة بحَدَبه عليها، وأحسب أن بعض النساء يتجاهلن هذه الفطرة الجميلة في الرجُل خوفًا من أن يفتح هذا بابًا للسيطرة، فيصرِّح بعضهن – بتطرُّف – إنهن في استغناء عن عطاءات الرجُل، وهنا يعتاد الرجُل ألَّا يَهَب، وألَّا يشملها بالرعاية والدعم، ثم ينسحب مع الوقت من مسئولياته تمامًا، ويعتاد الحياد.
العلاقة بين الزوجين أو الحبيبين تتمدَّد في منطقة تكامُل الأدوار وتبادُلها، بحسب احتياج كل منهما، ولا ينبغي لها أن تقع في منطقة الندية، ولا استعلاء أحدهما على الآخَر، ولا رغبات التسيُّد، فنحن لسنا بصدد مناظرة، ولا حرب تكسير عظام.
وفي تقديري إنه مع تحديث أوضاع المرأة وعصرنتها، علينا الاشتغال العميق على وعي المرأة، وتجاوُز تطرُّفها، سواء في احتياجها للرجُل بنوع من الاعتماد الكلي أو استغناء بعضهن المتطرِّف عنه، عليها أن تعتاد – حين تستطيع – جَمال أن تعطي الرجُلَ، أن تشاركه مسئولياتِ الحياة، لا أن تأخذ وتنتظر فقط، فحالة العطاء ذاتها تُغني مشاعرنا، وتُشعر الرجُل بتقدير المرأة له، تُشعر الطرفين بالمسئولية المشترَكة، العطاءات بأنواعها كافة المادية والمعنوية.
تشعُر المرأة التي تعشق رجُلًا بجَمال عطائه، تمتن له – لو شعرت إنه يحتويها بالمحبة بكل صورها – بالعناية به، الأجمل حين تشعُر أنه لا يَرِد على خاطره السيطرة عليها، أو التحكم في مسارات حياتها، فتلك منطقة الود الحقيقي والثقة، فكلَّما انطلقت أنسام الحرية والتعبير عن الذات في العلاقات بين البشر؛ كلَّما ازدهرت تلك الأواصر بين الطرفين، وتذوَّقا حلاوة التقدير المتبادَل.
منطقة أخرى تمامًا تختلف عن “الخضوع له بالقناعة وحُسن السمع والطاعة”، ما ينبغي توافُره بين الزوجَين. فكم هي رائعة منطقة الأمان، التي تنشُدها المرأة مع الرجُل، الاستكانة إليه، والتظلل تحت أجنحته، حيث الصحبة الذكية الحانية، ولا أتصور أن تتأتَّى تلك العلاقة المنشودة بالخضوع، والسمع والطاعة، بقدْر تحقُّقها حين تشعُر المرأة بأن الرجُل – الذي معها – رجُلٌ حقيقيٌّ، سندٌ يدعمها، يدرِك معنى مشاركة الحياة، يعي أنه ارتبط بذاتٍ حُرة، وأن مراعاة حريتها واستقلاليتها يجعلها أكثر تفتحًا وحرصًا عليه، رجُل يُدرك أن حوارَ العقل والوجدان أجملُ من فرْض الأوامر، فلن يسعَد الرجُل في علاقته بزوجته، ولن تَهَبَه أجملَ ما لديها وهو في موقع الآمِر الناهي، إنها منطقة الحوار، وأن يتقبَّلا فيها إضافة كل منهما للآخَر، أجمل كثيرًا من خضوع طرف من طرفَي العلاقة، والتي غالبًا ما تكون المرأة ضحيتها.
التلاقي في بعض وجهات النظر، وبعض نقاط ومحاور العيش يؤسس للسكن، وحين يظهر الاختلاف – وهو حتمًا سيظهر – يَظَل يجمع الطرفَين احترامُ الآخَر، لا الرغبة في أن يكون الطرفُ الآخَر صورةً منه، منسحِقًا ضمن إراداته، وإلا سيحدث القمع، مساحة الحرية والتواصل لا تجعل امرأة بلغَت ثمانين عامًا تطلب خُلعًا من زوجها، حتى لو ماتت غدًا، كما ذكرت.
علينا أنْ نلاحظ أنَّ موقعَ المرأة – في هذا النَّص؛ لتاريخيته – مستقبِلٌ فقط، موقع الخانع، وليس موقع الفاعل الإيجابي، حيث مساحة الخضوع وحُسن الاستماع إليه والرضا بكل ما يصدُر منه.
أفهم أن يفسَّر الخضوع هنا في مساحة التواصل والحنو، التدلل من المرأة، والاحتواء من الرجُل، فتلك طبيعة الطرفَين، ربما الفطرة التي خُلِقنا بها، أو التي أوجدتها طبقات موروثة من الوعي الثقافي المجتمعي، شُكِّلت طبيعة المرأة هكذا، وطبيعة الرجُل على هذا النحو، التدلل والاحتواء لا يظلِّل العلاقة بين الطرفَين إلا إذا شَعَرا إنهما وِحدة، كيان واحد، رغم احتفاظ كل طرف بخصوصيته.
يَسعَد الرجُل – بلا شك – باهتمام المرأة به، كما ذكرت أمامة: “التفقد لوقت منامه وطعامه، وحفْظ ماله، ورعاية عياله”، لكن الحياة الحديثة، وفي ظِل عمل المرأة، وكثرة مهامها خارج البيت وداخله، تجعل الرجُل يدرك أن مشاركة مهام الحياة والأُسرة مع المرأة دلالة على رجولته المستوعِبة الذكية، ونُضجه الإنساني، كما أن الجَمال أن تأتي هذه المبادرة منه لرعاية زوجته، للتخفيف من قدْر مسئولياتها في حياتهما المشترَكة.
وحين تقول السيدة أمامة: “لا تعصي له أمرًا ولا تُفشي له سِرًّا، وإياكِ والفرح بين يدَيه إن كان مغتمًّا، والكآبة بين يديه إن كان فرِحًا”. أحسب أن الأم الفَطِنة في 2025 ستستعير قول نزار قباني، وتقول لابنتها: “لا تقفي مثل المسمار”، أعني لا تتركيه مهمومًا، بل حاولي إسعاده والتخفيف عنه، كوني ذكية وفاعلة، لا تكتفي بموقف المستقبِل فقط، فابتسامة المرأة المُشرِقة تُبهِج الروح، وتبدِّد الوحشة والهموم والغربة. بادري بصُنع الجَمال، اللحظات الحلوة المكتنزة بالمحبة والتواصُل الرائق الممتع.
أما فيما يتعلق بالجَمال والنظافة، فأتفِق مع السيدة على الإطلاق، فجَمال المرأة وأناقتها، رائحتها العطرة، تُسعد الرجُل، تجعله يبقى في حدائقها، لكنني هنا أضيف أن الشكل الخارجيَّ غيرُ كافٍ، فإن وَجَدَ الرجُل جَمالًا داخليًّا، ووعيًّا ذكيًّا، وامرأة يستطيع الحوار معها؛ سيهتم برأيها لرجاحته، ولن يمَل منها سريعًا؛ وعي المرأة وثقافتها وجَمالها الداخلي ينعكس على جَمالها الخارجي، كما يُبرِز عمقَ روحِها وصفاءَها وثقافتَها.
ولعلنا نتساءل ما هو المعنى الحقيقي لأن تكون جميلًا؟ الجسد والمنظر الجميل والرائحة العطرة أول الأبواب التي لابد وأن تنفتح على أبواب أخرى أكثر اتساعًا، جَمال العقل الرَّحب، والوعي المثقَّف الذي يستوعِب الحياة بغِناها وتعدُّدها.
كما يَرِد – في الموروث الاجتماعي المصري والعربي – الكثيرُ من الأمثال الشعبية وبعض المقولات، التي نرصد فيها توجُّس كل طرف من طرفَي العلاقة الزوجية من الآخَر، سواء النساء أو الرجال، ففي الأمثال الشعبية تضع المرأة الفخاخ للرجُل، تنظر إليه من موقع الملكية، وبكل الطُّرُق عليه أن يظَل في فَلَكِها هي وأولادهما، كما يشكِّك الرجُل في قدراتها ويستخف بها، ويصوِّرها أحيانًا كيانًا يضمِر شَرًّا، التوجس الذي ترسَّب في الوعي الجمعي، وترْك منطقة عداء مبهمة.
فنجد أمثال بين النساء من قبيل: “قصقصي ريش طيرك قبْل ما يلوف على غيرك”، و”يا مآمنة للرجال يا مآمنة للمَيَّة في الغربال” و”ضِل راجِل ولا ضِل حيط”، و”جوزك على ما تعوِّديه وابنك على ما تربِّيه”، و”اغلبيه بالعيال؛ يغلبك بالمال”، و”الراجل ما يعِبُوش إلا جِيْبُه”. تترك هذه الأمثال في وعي النساء الجمعي بعض العداء للرجُل، واعتباره خائنًا وبلا أمان، كما أن ماله هو الأهم، حيث يمكِّنه من تعدُّد الزوجات، لذا تأتي القصقصة واجبة. وأحسب أن النساء يخسرن كثيرًا إذا كان هذا المنطق النفعي هو مُنطلَقهن للتعامل مع الرجُل، وأحسب أن كيان الرجُل المحِب هو أهم الهدايا التي يمكن أن تحصل عليها المرأة.
وعلى المرأة أن تدرك أن الرجُل يريد أن يشعُر بالتقدير ممن يعيشون معه، ويبذل من أجلهم، التقدير لشخصه قبْل عطاياه، لإنسانيته واحتوائه لعائلته، لكونه الكيان الذي يحتضن الجميع: امرأته وأولاده ووالدَيه.
كما نجد أيضا أمثالًا تحُط من شأن المرأة، مثل: “ادبَح لها القطة”، و”شُورة المرأة بخراب سنة”، و”اكسر لها ضِلع يطلع لها 24 ضلع”، و”يا مخلِّفة البنات يا شايلة الهَم للمَمَات”، “اللي يقول لمراته يا عورة؛ يلعب بيها الناس الكورة”. فالرجُل في هذا الوعي هو القادر على أن يُكسِب المرأة الأهمية، أو ينزعها عنها، كما أن التفكير وصلاح الشأن والقيمة الإنسانية والعملية تضفيها الثقافة الشعبية على الرجُل وتحرم منها النساء. ولذا يتعين علينا تفكيك وخلخلة تلك المفاهيم وإعادة طرْحها بما يتفق مع العصر الذي نحيا فيه.