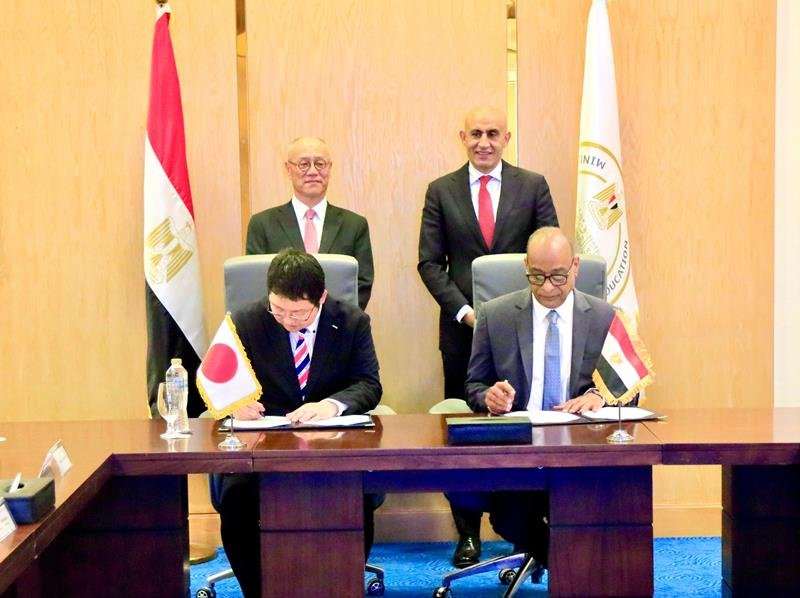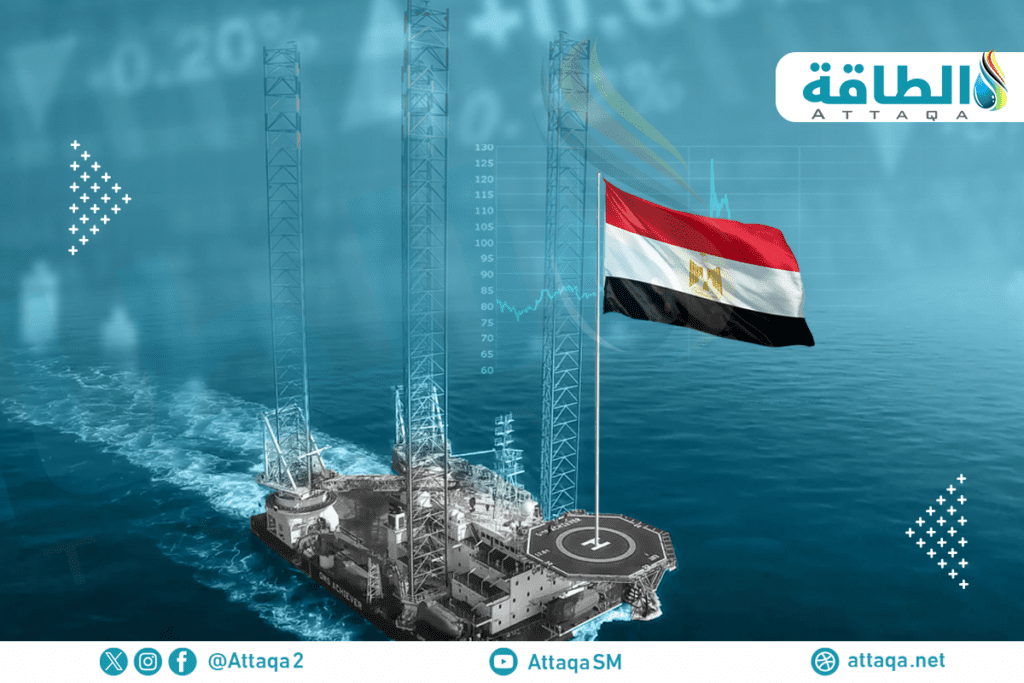بقلم دكتورة / أماني فؤاد
استكمالًا لِما طرحناه في المقال السابق، حول الأدب العربي ومعايير العالمية، لو تخيَّلنا أن عضوًا في لجان تقييم مجمَل تجارب الكتَّاب والروائيين؛ لاختيار من سيفوز بنوبل في الآداب، التي باللغة العربية، قد كُلِّف بقراءة بعض المشروعات الإبداعية للكتَّاب العرب، الذين رشِّحوا للجائزة؛ تُرى ما الذي سيواجه من عوالمَ تُطرح في النصوص، ومن أفكار، وهل تواكِب تلك الكتاباتُ – وما تتضمَّنه من أفكار، وما تشكلت به من فنيات – أحدثَ منجزات الحضارة البشرية العالمية، وتقنيات الكتابة ذاتها، أم سيواجهه الكثير من الأوهام التي تخطَّاها الواقع الدولي الإقليمي، والعالمي، وتخطَّتها الثقافات الأكثر تقدُّمًا؟ هل تغوص تلك المشاريعُ في قضايا واقعها ومجتمعاتها بعقلانية، وهل تستخرج نبْضَ مجتمعاتها فنيًّا ووجدانيًّا، ومهما استغرقت في عوالمها المتخيَّلة أو المَحلية، ذات الخصائص المميَّزة، والتي تدعو الآخَر للتعرف عليها؛ شغفًا بالجديد الذي لم يرَه ولم يعرفْه؛ هل تراعي تلك المشاريعُ أن تكون منطلقاتها الفكريةُ والوجدانية إنسانيةً عامة، يمكن أن تتقبلها الذائقة البشرية في أيِّ بقعة من الكون، وتتفاعل معها، وتشعر بأنها تمسُّها بشكل ما؟ أم سيجد الناقد – المفترَض لتقييم مشاريع البعض – مجموعةً من الأفكار المتيبسة المحنَّطة، واستغراقًا في بعض الأساطير التي لا يؤمِن بها إلا إقليم واحدٌ بثقافته الخاصة في هذا العالم المتسِع؟
(1) قد يجد على سبيل المثال دفاع الكثيرين من الكُتَّاب، وخاصة الأجيال الأكبر سِنًّا، عن أحلام القومية العربية، والعروبة، والقضية الفلسطينية المحورية، حيث الصراع مع إسرائيل، والمشروع الناصري، وتباكيهم المستمر على الحلم، والعهد الذي انقضى بكل سلبياته وإيجابياته، رغم إدراكهم لأخطائه، التي لم تزَلْ تؤثِّر في الواقع العربي حتى الآن، ورغم أن الواقع والصيرورة التاريخية وسيولة الأيديولوجيات وتبدُّدها – منذ منتصف القرن العشرين – أثبت وقوع تلك الأفكار ضمْن مساحات الحلم والطوباوية، التي غرقت تمامًا مع مواجهتها لأرض الواقع، إلا أن القومية والوحدة العربية لم تزل تخاتل البعض ويدافعون عنها، هل يمكن أن تصمد تلك الاستراتيجية، وخاصة في بقعة جغرافية يتحكم في شعوبها تراثٌ ممتد من القَبَلية والانحيازات، تلك التي تحرِّكها النزَعات الاستعلائية، والكثير من الاعتبارات العاطفية، التي تجانب العقلانية والموضوعيةَ بصورة كبيرة، وتعتمد على موروث من الخرافات؟
أو قد يجد الناقد مآخذا واسعةً على تلك المرحلة الزمنية، وسخطًا على كيفية معالجة القضايا السياسية في هذه المرحلة، وقد يشعر كأنَّ حركة الزمن قد توقَّفت هناك عند الناصرية، ولم تبْرح تلك السنوات، وأن المقارناتِ – رغم سريان الزمن، وتبدُّل السياقات – لم تزَل قائمةً بين هذه الفترة من الزعامة، وأيِّ زعامة أخرى، هذا مع ملاحظة تهاوِي فكرة الزعيم والأب والحاكم المطلَق الملهَم ذاتها من مفاهيم حكم الدول، وهنا قد يدرِك مَن يرصد تلك الانشغالاتِ أنه لا اعتراف بالتاريخانية في هذه الثقافة.
(2) قد يجد هذا الناقدُ منظومةً من العلاقات المجتمعية الغريبة، وعيًا جمعيًّا لشعوب تتحكم فيها موروثات وعادات اجتماعيةٌ تخطَّتها الثقافات البشريةُ، رفَضتها لِما يكتنفها من سلبيات لا تتسِق ومفاهيم متجددة عن الإنسانية والوجود والميتافيزيقا، حيث الذات الفردية التي أصبحت ديانةً جديدة في الحضارة الغربية، وفيها الإنسان هو الغاية من كل شيء، هذه الشعوب وسُلطاتها السياسية، التي وثقت في الفرد ومبادراته وأفكاره، ووهَبته الحرية ليُبدع ويفكر ويتخيل ويفعل ويجرِّب، وهَبته الحرية، دون سُلطات تراقِب وتصادِر وتكفِّر وتحرق وتحرِّم، ثقافات مَرَّ مواطنوها - بطبقاتهم وشرائحهم – بمراحل إنتاج وتطوُّر الكثير من الفلسفات والتجريب العلمي والأفكار والإبداعات، الكثير من العلوم الإنسانية والعلمية التجريبية؛ فصُقلوا، وتميزت لهم أبعاد متعددة، وليس بُعدًا واحدًا، بَنُوا طبقاتٍ من المعارف والرؤى والفلسفات والعلوم، فوق الأساطير والأديان والخرافات، فيما يُعرف بالتراكم المعرفي، ونحن لم نزَل نخشى مواجهةَ سيطرة الخطابات الدينية والاجتماعية، التي تحكُم حياتَنا، وكلَّما برَز على واجهة أيِّ مشهد أحدُ القيادات في أيِّ مجال؛ مَحَا وشكَّك فيمَن كان قبْله، ولذا يتحايل المفكرون والمبدعون – بكل الأدوات والتقنيات – لتقديم خطاب متردِّد مرتعش، وعطاءات رمزية مراوِغة، تتوسل بالكنايات؛ لمواجهة هذه الرؤى والفتاوَى والعادات والتقاليد الجامدة المتعصبة. هناك فارق كبير بين من يُنتِج جديدًا في كل لحظة، من يراكِم ويبني طوابقَ من العلوم والأفكار، ويصنع لها ومعها مناخًا جدليًّا متجددًا؛ فتتغير وتنمو مكونات شخصيته الذاتية، وتتغير وتتطوَّر منظومة علاقاته في مجتمعه، ومن ثم يتحقق، لا يعاني من التهميش؛ فيقبَل بالتعدد، وينظر للاختلاف بحُسبانه مساحات للجدل الثري، يعي مفاهيم العمل المشترَك، وقدْر أهمية عطاءات المجموع معًا، ويتسامح مع الاختلاف بكل صوره، والآخر الذي ينظر خلْفه على الدوام، وتتراوح خطواته بين الماضي والحاضر، نظرات مترددة وحائرة، ويظَل يناقش القضايا ذاتها لمئات السنين، فيقع صريعًا للخوف من عَيش اللحظة بكل زخمها واختلافاتها عن ماضٍ وسلَفٍ انتهت مقتضيات لحظتهم وسياقاتهم، بكل ما لها وما عليها. هذا بالرغم من وعينا بأن للحضارة الغربية أيضا مشاكلها الكبيرة مثل تبعات الرأسمالية المتزايدة على الأفراد، وصعود التيارات اليمينية في مواجهة الهجرة إلى أوروبا.


(3) قد يجد الراصد – في الكثير من الآداب العربية في مجملها – تشتُّتَ وتراوحَ مشاريع إبداعية ضمْن مناطقَ زئبقية، مناطق تخشى من أن تصارِح بموقف صريح، وتفضِّل أن تُقيم في منتصف القضايا والمعاني، ففي الثقافة العربية تظَل مقولة “الأصالة والمعاصَرة”، بينية وحائرة لدى الفُرقاء، تعتمد على التلفيق والتوفيق، بعض النُّخب تختار القطيعة مع الموروث، وتنجذب لمعايير الثقافة الغربية، فتأتي جموع العوام، وتحكُم عليهم بالرفض أو النفي خارج مجتمعاتها، أو قد تحكُم عليهم بالقتل؛ لِما يقدِّمونه من مجرد الأفكار والآراء.
فجموع العوام دائمًا ما تقع تحت وطأة تكرار بعض الخطابات الدينية المتغلغلة في وعيهم الجمعي، ضمْن ميراث من خطابات الإقصاء والكراهية، تلك التي تسْخر من التعايش مع المختلِف، سواء في العقيدة أو القومية، إلا بشروط غير عادلة، وتُشيع الكراهية، وتجدِّد أفكارًا من قبيل: دولة الخلافة، وأفكار السلَف، والجهاد لإقامة أمَّة إسلامية تسيطر على الجميع، كما نواجَه بأسئلة خارج منطق الأشياء من شرائح من المفترض أنها واعية يطالبون بأدب إسلامي، أو يتساءلون حول لماذا لا توجد نظرية نقدية عربية، لماذا ونحن خير أمَّة أُخرجت للناس، فنحن أصل العلوم والاكتشافات، وفي كتابنا الأول المقدَّس الفصلُ في كل الأشياء. أسئلة وخطابات خارج التاريخ والواقع وتطوُّر المعارف والحضارات.
وينحصر مفهوم “الأصالة” – في منظور هؤلاء – بأنه على حياتنا المعاصرة أن تتحرى كونها صورة من السلَف، الذين هم حجَّة على كل شيء؛ لاقترابهم من عصْر الرسول، لا يفكرون في في الأصالة بحسبانها تعبيرا عن ذواتنا وهمومنا وطموحاتنا، أن نتحرَّر ونتخيل ونفكِّر ونبتدع ونفعل، أيَّ حالة من الحراك والتنشيط لمخيلتنا وعقولنا.
(4) قد يجد ناقد التحكيم في نوبل – على سبيل المثال – نصوصًا وأعمالًا شعرية أو سردية لكاتب كبير، أنتج مشروعًا ضخمًا، لكنه قد يلحَظ الغموض المغرِق في فضاءات مضببة، لن يستطيع أن يعِيَها سوى الكاتب، لن يدرك أبعادها سواه، قد يشعر الراصد بأن المنتَج الأدبي لا يبني جسورًا مع المتلقي، ولا يكترث به، قد يجد أن العوالم شديدةَ التراكُب والتعقيد، تتوسل بالتصوف والفلسفات والموروثات والأساطير، والفلكلور، والكثير من الاستدعاءات والتناصَّات من كل الموروث العالمي؛ فتضيع وتتشتت الطرُق المشترَكة.
أو قد يجد الناقدُ الكاتبَ العربي – في مُجمل أعماله – سابحًا في عالم الخيال، ورومانسية التناوُل، وهنا لا أقصد تيارَ الرومانسية، الذي يستغرق في العواطف، قدْر ما أعني رؤية رومانسية وطوباوية للحياة، دون مواجهة حقيقية مع مشكلات الواقع، حيث تخيَّر خلْق عوالمه الخيالية البعيدة عن مقتضيات الواقع، كأنه لا يراه سوى معقَّم، لا تلتفت عدساته لطفيلياته ومكروباته القاتلة.
في ثقافتنا، كثيرًا ما أُجهضت كل مشاريع النهضة والرغبة في العبور من تبعات وآثار اختيار مذهب النقل بدلًا من إعمال العقل والاجتهاد والابداع، وغلبوا العودة إلى الماضي واستمرار الاضطهاد المسلَّط على المرأة، وثقافة الخرافات، وإعلاء كل تلك الإيمانات على العقلانية والموضوعية، وتشجيع الإبداع والعِلم والتجريب.
(5) قد يجد الناقد أيضا جَلْدًا للذات، ومقاراناتٍ مستمرةً مع الآخَر، وشعورًا بالدونية؛ نتيجة لقرون عانينا فيها من الاستعمار بكل أشكاله، وهو ما لا ينبغي أن تشغَل أصداؤه السردياتِ بهذه الهيمنة، حتى لحظتنا المعاصرة. لن يجد علاقاتٍ قد تحرَّرت من التوجُّس، تخطت فتراتِ الاستعمار، وما حدَث خلالها من استغلال خيرات البلاد، التي تمَّ استعمارُها، لدينا دومًا شعور بالاستعلاء الغربي، والاختلافات في الثقافة العامة.
هل سيَجِد هذا الناقد أن السردياتِ العربيةَ تضع نواقصها وأخطاءها أمام أعينها، وتنتقدها، وتنسبها لعيوب ثقافتها العامة وسياساتها، والتقاليد الرجعية لمجتمعاتها؛ بمعنى إنها لن تنسِب كل الفشل للغزو الثقافي، الذي يأتينا من الخارج والغرب، هل نواجِه ثقافتَهم بإنتاج ثقافة أخرى إنسانية، تتضمن معايير الحضارة، التي تتضمن مقومات النجاح، هل سنضع آليات الدفاع التي ننتجها باستمرار في مكانها وحجمها الحقيقي، ونعي عيوبَنا ونواقصنا دون أن نضع أسباب الفشل كلها على الآخَرين وما يريدون بنا؟
في نهاية تلك الافتراضات، يمكنني القول: إن مشروع نجيب محفوظ الإبداعي السردي المكتمِل تمتَّع بما يمكن وصْفه بالأدب الوازِن، المتَّسِع، الذي استوعب الكثير من تيارات الكتابة على مَرِّ عُمره الممتد إلى تسعين عامًا، أدب يجادل، وينتصر للعِلم والعقلانية، وموضوعية الطرح، كما أنه الأدب الذي أبرَز الهُوَية والشخصية المصرية بمراحل نهضتها وأجيالها، أدب لا يُقصي شريحة أو طائفة؛ بل يحتوى ويتضمن ويحتضن الجميعَ من خلال تعدُّد عوالمه، الأدب الذي يوظِّف مخيِّلَته لهدْم وتحطيم معايير الكتابة العربية التقليدية؛ ليقِيْمَ عوالِمَه هو، الأدب الذي يشتبك مع الواقع من منظور تنويري، والذي لا يتخلَّى عن عوالم المخيَّلة والفنتازيا؛ بل يجد لنفسه المساحاتِ والموضوعات ليبرِزَها، ذلك الأدب الذي يمتِّعك، ومعه تفكر وتتخيل وتحلم.
ليس معنى الطرح الذي قدمته أن كل الأدب العربي على هذا النحو، فلقد تخطى القليل من الأدباء الأحدث الكثير من تلك الأوهام والأيديولوجيات، وقدموا نصوصا تستحق الفخر والإعجاب، ولنا في المستقبل الكثير من الآمال.