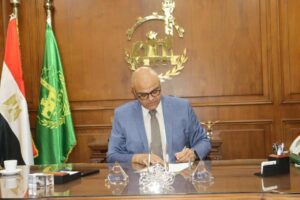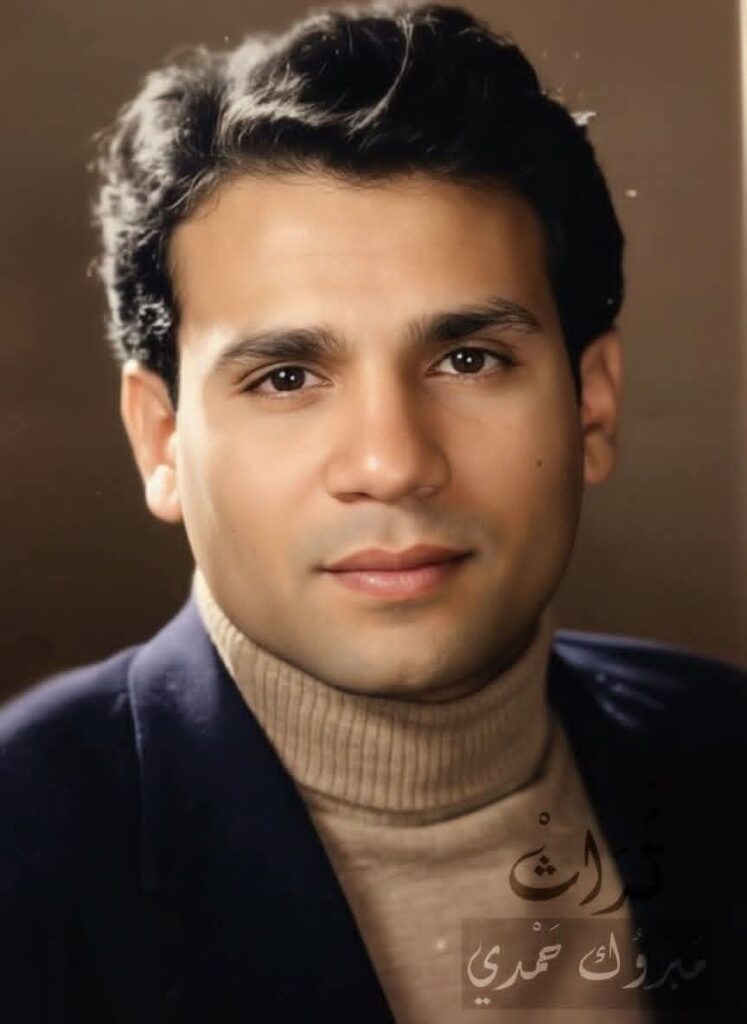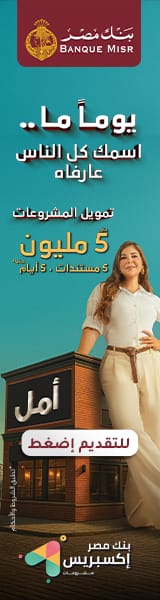كتبت / سلوى لطفي
رغم أنّ الفصام مُصنّف بين أشهر الأمراض النفسية، إلا أنه أكثرها سوءًا للفهم. فبحسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي، يؤثّر الفصام على حوالي 0.32% من سكان العالم، أي قرابة 24 مليون شخص .
الفصام اضطراب مزمن في الدماغ،
- الذهان،
- والأوهام،
- والهلوسة،
- والبارانويا (جنون الارتياب) وانعدام الدافع،
- والتفكير والكلام غير المنظَّمَين.
أما أعراض النمط النموذجي فتبدأ بالظهور في أول مرحلة البلوغ، وتتفاقم جميعها مع مرور الوقت.
اضطراب يُساء فهمه
جزء من الالتباس حول الفصام مردّه إلى الاسم. ففي العام 1908، صاغ الطبيب النفسي السويسري بول أويغن بلويلر مصطلح “الفصام” (Schizophrenia)، المشتق من كلمتين يونانيتين:”schizo” وتعني “انقسام”، و”phrene” وتعني “العقل”
ومن أجل وصف الانسحاب الاجتماعي الشديد الذي يُظهره بعض مرضى الفصام، ابتكر بلويلر أيضًا مصطلح “التوحّد”.
وفي مطلع القرن العشرين، اقترح بلويلر أنّ الفصام يتميّز بـ”انقسام الوظائف النفسية”، ما يؤدي إلى “فقدان الشخصية وحدتها”.
يقول الدكتور دانيال وينبرغر، المدير والرئيس التنفيذي لمعهد ليبر لتطوير الدماغ، إنّ فكرة الفصام تعني “انقسام العقل”، ساهمت بانتشار الاعتقاد في الأوساط الرسمية بأنّ هذا الاضطراب يشبه اضطراب تعدّد الشخصيات (المعروف سابقًا باسم اضطراب الشخصية المتعدّدة أو الانفصام الشخصي)، الناتج عن الصدمة النفسية، عندما تتحكم شخصيتان مميزتان أو أكثر في سلوك الفرد، ما يؤدي إلى فجوات بالذاكرة عند تبديل الشخصيات
وبعيدا عن هذه المفاهيم الخاطئة حول طبيعة الفصام الأساسية، يشير الدكتور ديباك ديسوزا، أستاذ الطب النفسي ومدير مجموعة أبحاث الفصام في جامعة ييل، إلى أن الفصام يُعتبر من أكثر الاضطرابات النفسية الموصومة.
ويضيف الدكتور جيفري ليبرمان، أستاذ الطب النفسي في جامعة كولومبيا، أنّ هناك صورة نمطية واسعة الانتشار تُصور الأشخاص المصابين بالفصام كخطر على الآخرين، مثل “الشخص المشرد الذي يمشي حافي القدمين في الشتاء ويصرخ بلا هدف، أو القاتل المتسلسل المدفوع بأعراضه لقتل الغرباء”.
ويتابع ليبرمان، مؤلف كتاب “مرض العقل: الفصام وطرق الوقاية”، أنّ الفصام هو الحالة التي يرتبط بها الناس عادة بـ”الجنون والذهان والجنون التام”. وفيما تستند بعض هذه الصور النمطية إلى أعراض حقيقية يعاني منها بعض المرضى، إلا أنها لا تصيب كل المرضى، وقد تحد النظر إلى الفصام كاضطراب يمكن علاجه بشكل شامل ورحيم، ما يكون ضارًا للمريض أكثر من كونه خطرًا على الآخرين
ويقول ليبرمان إنّ “طريقة تعامل المجتمع مع الفصام، منذ العصور القديمة حتى العصور الوسطى، ووصولًا إلى القرن الـ21، تمثّلت بنبذ أو عزل الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات النفسية الشديدة”.
ويشير الخبراء إلى أن سوء الفهم والمخاوف المتعلقة بالفصام قد تصعّب على الأشخاص التعرّف على علاماته وطلب المساعدة لأنفسهم أو للآخرين، لا سيما أنّ هذه المساعدة ضرورية لأنّ الفصام يرتبط بمشاكل نفسية أخرى، وبانخفاض جودة الحياة ومتوسّط العمر، وارتفاع معدلات العجز، وفق المعهد الوطني للصحة النفسية
لذلك ، ثمة اهتمام متزايد بين بعض الخبراء لتغيير اسم هذا الاضطراب المزمن في الدماغ. وبين الأسماء البديلة الأكثر دعمًا بحسب استبيان أُجري في العام 2021، شمل نحو 1200 شخص، بينهم من عانوا من مرض نفسي، وأفراد عائلاتهم، وأطباء، وباحثين، ومسؤولين حكوميين، وعامة الناس: متلازمة الإدراك المتغيّر، أو متلازمة طيف الذهان، أو اضطراب التكامل العصبي-العاطفي.
متى يبدأ الفصام ولماذا؟
تبدأ أعراض الفصام بالظهور عادةً بين سنّ 15 و25 عامًا، وفق الخبراء.
فبحسب وينبرغر، الذي يدرّس أيضًا الطب النفسي، وطب الأعصاب، وعلوم الأعصاب، والطب الجيني في جامعة جونز هوبكنز: “قد يعيش الأشخاص حياة طبيعية أو حتى ناجحة، ثم فجأة يمرّون بما يسميه الخبراء بـ’الانفجار الأول’ في قدرتهم على الأداء الطبيعي
ويضيف ديسوزا: “بالنسبة لي، الفصام من أكثر الأمراض النفسية تدميرًا، لأنّه يُصيب الشخص قبل أن يصل إلى كامل إمكاناته”.
وتُشير الأبحاث إلى أنّ هذا الاضطراب قد ينجم عن تغييرات في العمليات العصبية التنموية الطبيعية التي تحدث أثناء نضوج المراهقين، خصوصًا أنّ نهاية النطاق العمري المعتاد لظهور المرض المتزامن مع اكتمال نضج الدماغ، وفق ديسوزا.
أما وينبرغر، فأوضح أنّ لدى بعض الأشخاص قد تبدأ هذه التغيرات منذ الطفولة المبكرة، وتتطلب حوالي 20 عامًا من نضج الدماغ لتظهر آثارها بوضوح.
ولفت ديسوزا إلى أنّ هناك أشكالًا من الفصام قد تبدأ في سن أصغر، لكنها حالات نادرة، موضحًا أنّ “الفصام يُصيب غالبًا الذكور”، لكنه أشار إلى “وجود ذروة ثانية مثيرة للاهتمام في معدلات الإصابة بالفصام تظهر في مطلع الخمسينات من العمر، وهذه تُصيب في الغالب النساء، لاعتقاد بأن ذلك مرتبط بمرحلة انقطاع الطمث”.
ويُتابع وينبرغر أنّ السبب المباشر للفصام غير واضح، لكن هناك عوامل خطر عديدة معروفة، تشمل الكيمياء الدماغية والوراثة التي تزيد من احتمال تطور الاضطراب إذا تراكمت عوامل الخطر بشكل كافٍ. كما أظهرت العديد من دراسات التصوير العصبي وجود تشوهات هيكلية في أدمغة المصابين بالفصام، لكنها ليست متسقة بدرجة كافية عبر مجموعات المرضى لكي تصبح سمات مميزة للمرض.
ويلفت وينبرغر إلى أنّ الحمل المضطرب بعوامل مثل تسمّم الحمل، أو طول فترة الولادة، أو انخفاض وزن الولادة قد يُضاعف خطر إصابة الطفل بالفصام. كما يمكن أن تزيد الضغوط النفسية والصدمات من احتمالية الإصابة بالمرض.
الدور المحتمل لمواد مخدرة
قد يؤثر تعاطي المواد المخدرة على العقل في سن المراهقة أو الشباب، ما يشكّل عامل خطر آخر. وتشير الأبحاث إلى وجود ارتباط متزايد بين استخدام القنب (الحشيش) والفصام.
وبحسب ديسوزا يُحتمل أن يعود سبب الزيادة جزئيًا إلى أن قوة تأثير القنب اليوم، تتراوح بين 5 أضعاف و20 ضعفًا ممّا كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي، مضيفًا أنّ “الشباب يستخدمونه في وقت يمر فيه الدماغ بتحولات كبيرة”.
فالمواد الكيميائية النشطة في القنب تحاكي الجزيئات الطبيعية في الدماغ المعروفة باسم الإندوكانابينويدات (endocannabinoids)، التي تنشط مستقبلات القنب (cannabinoid receptors)، والعنصران يشكلان معًا ما يُعرف بنظام الإندوكانابينويد في الدماغ.
وأوضح ديسوزا أنّ هذا النظام غير موجود لتسهيل الشعور بالنشوة، بل من أجل تنظيم مستويات ونشاط النواقل العصبية، التي تؤثر على المزاج، والتعلم، ودرجة حرارة الجسم، وغير ذلك. كما يلعب هذا النظام دورًا حاسمًا في النمو العصبي، إذ يتحكم بهجرة بعض الخلايا العصبية، وإزالة أخرى، والتعامل مع أي اضطرابات خلال تطورها.
ويرى وينبرغر أنّ الأبحاث المتعلقة بالقنب والفصام مثيرة للجدل، إذ لا يمكن استنتاج علاقة سببية مباشرة لمجرد وجود ارتباط بينهما.
أعراض الفصام


هناك فئات عديدة لأعراض الفصام يمكن أن تؤثر على مشاعر الأشخاص، وأفكارهم، وتصرفاتهم.
ويوضح وينبرغر أّن الأوهام، وهي تصديق أشياء غير حقيقية أو واقعية، والتصرف بناءً عليها، أمر شائع في الفصام، مضيفًا أنّها يمكن أن تكون مزعجة للغاية، ومعذّبة، ومعيقة جدًا للحياة.
وبحسب وينبرغر يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالفصام أيضًا من الهلوسات، مثل التحدث مع شخص غير موجود، مضيفًا أن الأوهام والهلوسات قد تؤدي إلى الخوف والبارانويا. والأخيرة تجعلهم يعتقدون بأن الآخرين يتحدثون عنهم، أو يتآمرون ضدهم، أو يؤثرون على أفكارهم أو يقرأونها، ما يشعرهم بعدم الأمان في الأماكن العامة.
ويعلّق بأنّ “معظم المصابين بالفصام يشعرون بعدم الأمان أكثر مما يخيفون الآخرين”.
وأوضح الخبراء أن الهلوسات غالبًا ما تكون على شكل أصوات، قد تبدأ أحيانًا بأشكال لطيفة لكنها قد تصبح مظلمة مع مرور الوقت. كما أن العديد من المرضى يسمعون أصواتًا متعددة تتبادل الحديث بشأنهم.
وبحسب وينبرغر هذه الأصوات قد تأمرهم بأداء أفعال يصعب مقاومتها، حتى وإن كانت مدمرة لأنفسهم. ويشير إلى أن نسبة الانتحار بين المرضى تتراوح بين 5% و13%، وأحيانًا السبب مرده إلى اتباع الأوامر الهلوسية لأداء أفعال قاتلة.
ويلفت وينبرغر إلى أنّ الأشخاص المصابين بالفصام قد يعانون من ضعف في القدرات الإدراكية، مثل صعوبة بوضع الخطط وتنفيذها، أو معالجة المعلومات المعقدة، أو استخدام المعلومات للوصول إلى استنتاجات مناسبة، مضيفًا أن الكلام غير المنظم، والحركات الغريبة، وقلة الدافع تعتبر أعراض شائعة أخرى، بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية.
ليس شفاءً كاملاً بل تحسن
لا يمكن علاج الفصام تمامًا بحسب ليبرمان، لكن استخدام مزيج من الأدوية والعلاجات قد يُخفف من حدته.
ووفق ليبرمان فإنّ أكثر الأدوية فعالية للمرضى هي مضادات الذهان، التي تتحكم بعناصر الذهان التي تؤثر على التفكير والإدراك. أما الصعوبات الإدراكية فهي أصعب في العلاج، برأي وينبرغر، الذي أضاف أن أكبر عقبة في العلاج تتمثل بعدم تناول المرضى أدويتهم بانتظام، ومردها أحيانًا إلى حالة تُعرف بـ”الجهل بالمرض” (أنوسوغنوزيا)، أي عدم وعي المريض بأنه مريض، وتؤثر على 50 إلى 98% من المصابين بالفصام. وأحيانًا يكون السبب الآثار الجانبية غير المريحة للأدوية.
لكن مع تقدم الفهم العلمي لعوامل الفصام المسببة، هناك أدوية جديدة قيد الدراسة أو التطوير يُتوقع أن تكون أكثر فعالية وآثارها الجانبية أدنى، بحسب وينبرغر.
أما العلاجات الفعالة فتشمل العلاج بالكلام، وتدريب مهارات التواصل الاجتماعي، والعلاج السلوكي المعرفي للذهان، كما أوضح وينبرغر وديسوزا.