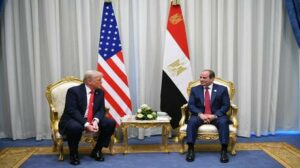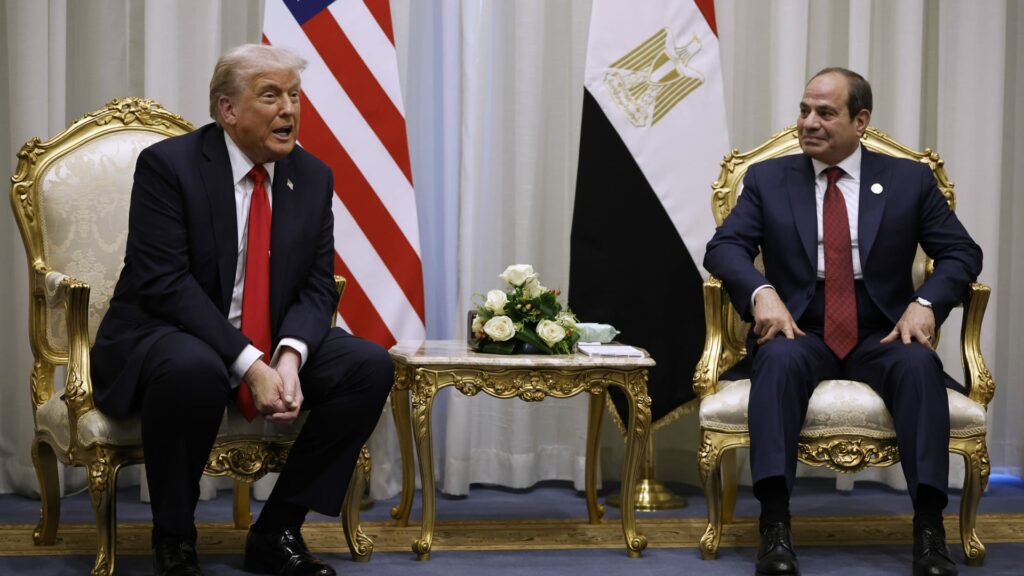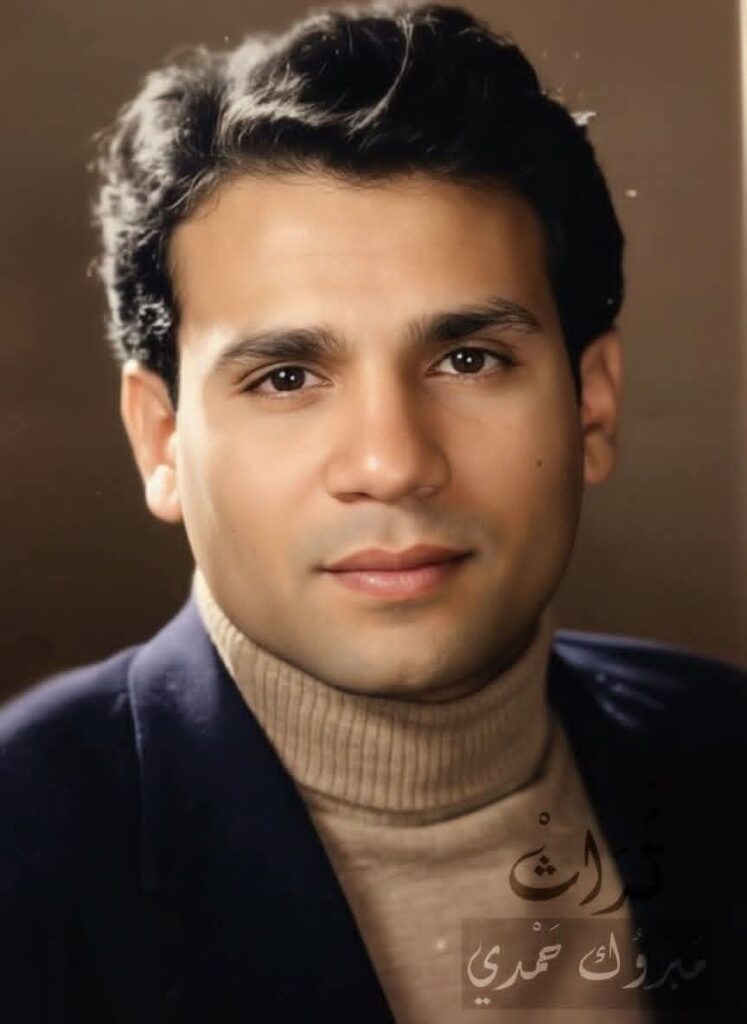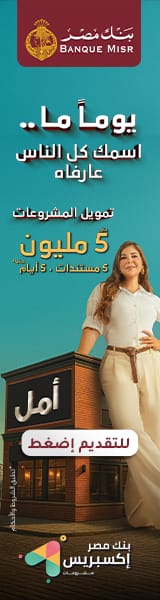بقلم الأستاذة الدكتورة / أماني فؤاد
في هذه الرواية القصصية “حكايات الغماز” لهبة الله أحمد، يبرُز إله جميل وإنساني للغاية، يناجيه ويتحدث معه شخصيات القصصِ الرئيسةُ، والثانوية أيضًا، ويفارق إلى حَدٍّ كبير إله علماء الدين والفلاسفة، رؤية غير مقيَّدة بفلسفات العقيدة، أو أساليب محفوظة ومتواترة للحديث مع الله، فجميعهم – وبحسب معاناة كل واحدة وواحد منهم، وباختلاف طبقاتهم الاجتماعية – يتحدثون مع الله الخالق، بحسبانه الأب، والصديق، بحسبانه العارف، وشريك المعاناة التي يتكبدها الإنسان على هذه الأرض، فمنذ قصة “صباح الخير يارب” تناشده “سعدية” بائعة الجبن والبيض تقول: ”صباح الخير يارب، بحق جاه حبيبك النبي يارب تصبَّحنا وتربَّحنا، وبين عبادك ما تفضحنا، وتستر بنتي وتنجَّحها، واشوفها دكتورة قد الدنيا، شاحتاها منك يارب، انصِفني بها.. ده أنا جاية من سَفر يارب، وشيخ الجامع قال دعوة المسافر مستجابة، ما أنت سيد العارفين يارب، أنا مش باخبِّي عليك حاجة، هو أنا ليا غيرك!” (ص18) هو هذا الالتصاق الجميل دون شعور بالرهبة.
وعند رصْد اللغة التي تستخدمها الكاتبة، وتراوحها بين الفصحى البسيطة، والعامية المصرية؛ نستشف قدْر التلقائية المحبَّبة، التي تتسرب إلى القلوب مباشرة، هذا عدَا مستوى الصِّدق المتناهي، الذي يجسِّد ذاتًا مأزومة، تشعر بالمسئولية، بعد ترْك زوجها لها ولابنته؛ لأنها لم تستطع الإنجاب مَرَّة ثانية، كما تخشى من أن يُعَيِّر الناس – في قريتها – ابنتَها؛ لعمل أمها بائعة للجبن.
في تلك النصوص نلمس جَمال الإله الساكن أرواحنا دون تعقيدات، والعليم بما يعانيه الأفراد وما يأملونه.
في قصتها “رب القلوب غالب” يبرُز الإله الواحد، الذي يظلِّل الجميع دون تفرقة بين الرسالات، فينشِد (أبو النور مدني)؛ المسيحي ذو الأصول السودانية، الذي عاش في السودان في طفولته، ثم انتقل للصعيد المصري بعد أن اضطهدتهم الجماعات الإسلامية المتشددة، ثم أراد أبوه أن يعيش في منطقة ساحلية؛ فانتقلوا للإسكندرية مع العائلة، ينشِد ويمدح بصوت أشبه بسلاسل من أزهار ومحَبة دافئة للرسول وأهل البيت، وللإنسان المتعَب بمعناه المطلَق، وهو لا يرى فارقًا يفصِل الإنسان عن أخيه في الإنسانية، ولا الديانة، ولا الفن وتشكيلاته وموضوعاته، يقول له محمد عطوان ناظر المحطة:”يا عم مش هَتبطَّل دوشتك بتاعة كل يوم دي بقَى؟ وبعدين أنت مش مسيحي؛ بتمدح نبينا ليه بقى؟
- يا حضرة الناظر سماح! سماح يا حضرة الناظر، وبعدين مش بتقولوا ده نبي الناس كلها؟ ولا هو مدني مش من الناس؟ ولا أبو النور يعني مالوش نصيب في النور؟” (ص40) يطلب المدني من الناظر: “بس تأخذني معاك أبو العباس يوم الجمعة بعد المغرب أحضر حلقة الذكر.
- تدخل الجامع ازَّاي وكمان تحضر حلقة الذِّكر يا شماس يا بتاع الكنيسة! يا عم دا أنت لا حد عارف لك مِلة ولا بلد!” (ص41)
وتتحدث حياة إلى الله عاتبة في غضبٍ، تقول بعد أن رفَضها رجُل أربعيني في المحطة، وأهانها: “يعني عاجبك كدا؟ ما هو لو ما كنتش سايبني؛ ما كانش بقَى ده الحال.. اشمعنَى أنا اللي سايبني؟
يا عالم الأسرار عِلم اليقين/ يا كاشف الضر عن البائسين
يا قابل الأعذار عدنا إلى/ ظِلك؛ فاقْبَل توبة التائبين
استطردت بنظرة كسيرة عاتبة للسماء: كم مَرَّة تُبت إليك! ليه لم تتقبَّلني؟” (ص87) هذه التلقائية الإنسانية تقف في مواجهة أعتى خطابات التشدد الديني، لتَهَب معنًى أكثرَ تسامُحًا مع مفاهيم الربوبية والدين.
ــ المشهدية في المجموعة الروائية القصصية
تتمتع بنْية المشهد في هذه المجموعة بالتميُّز الشديد، حيث تجمع القاصة بين دِقة اختيار التفاصيل الفارقة، التي تبرُع في التقاطها، وتهَب طبيعة خاصة للقَص، بانتقاء مفردات الحكْي، كما بإمكانها أن تمنَح مَشهدَها حركية، تهَب القَصَّ حيويةً؛ فيبدو المشهد وكأن حركته مرسومة على خشبة مسرح؛ (الميزانسيه) كما يطلِقون عليها. وتتراوح بعض المَشاهد بين الواقع والحلم، تلتقط رغبات الأرواح، وتنير الكهوف النفسية بأساليبَ عذبة خفيفة الظل أحيانًا، كما في قصة ابن المحطة، أو قاسية في أحايينَ أخرى، كما في قصص مختلِس، أو الجاثوم، أو موعد ثابت، أو شيفون أحمر.


يقول المدني: “وجدت سيدة ترتدي سواد الأيام كله، من رأسها حتى أخمص أصابعها، تدور حول قبر ابنها؛ لا تنوح وتعدِّد وتدهن وجْهها بالنيلة وتحجل حافية كعادة النساء هناك؛ وإنما تغنِّي. تكرر فعلها كل خميس. تصفِّق بتؤدة، وتهتز بهدوء كالنيل، تمد النبي وآل البيت بل والعدرا أيضًا، في شجن يقتلع حواشي القلوب، تصبِّر قلبها على وليدها بالذِّكر. على ما أذكرها كانت ضامرة القَد، لها عين بيضاء، صوتها لم يكن جميلًا بالمعنى المتعارف عليه، وإنما به وجْد ينزع روحك منك نزعًا، وكأنما الإطراب بالوجد وحلاوة الحِس لا الصوت.” (ص43) يعتقد مَن يقرأ منذ البداية أن السيدة التي يتحدث عنها جِنيَّة، لكنه طقْس امرأة فقدت ولدها؛ ولذا أطلقت وجْدها يغني ووجدانها، تحدِّثه وتبثه حزنَها ومحبتها معًا، ومن فرْط تأثيرها صارت أم مدني – حين فقدت ابنها – تمارس معها طقوسها كافة.
في قصة “ابن المحطة” وجد (سفروت) رضيعًا ملفوفًا بشالٍ أسودَ، تحت أحد مقاعد المحطة، أخذته كردوسة بائعة الشاي في المحطة، من ساعتها أصبحت المرأة خط دفاعه الأول الجميل، والشرس أيضًا، تعلَّم سفروت النشل؛ لكنَّ أمَّه بالتبني تريده ضابطًا. فتتخلق المفارقات بين ما نريد ونأمل، وما ترسمه الأقدار لحيواتنا.
يقول السارد: “يرسم سيجَه بطبشور على الرصيف، يحجل وينافس نفسه، انتصر عليها مرَّتَين إلا إنها باغتته وهزمته مَرَّة، ضحكته حلوة على الرغم من الشقاء البادي على مظهره، يحمل روحًا محلِّقة، وعلى ذِكر التحليق، مَرَّ سِرب طيور من فوق المحطة، ظهَر كسحابة سريعة؛ جرى سفروت مرفرفًا على الرصيف، وهو يطلِق صوتًا أشبه بصوت أزيز طائرة، نادته كردوسة: “يا ولا، إوعى تطير .. فاكر نفسك طيارة!” (ص65)
خطَر لي – في عدد من المَرَّات، وأنا أقرأ المجموعة – أنني لو أردت رسْم بعض شخصيات هذه القصص؛ لاستطعتُ دون صعوبات تُذكَر، وذلك لقدرة الكاتبة على الإمساك بروح الشخصيات الداخلية، بطبيعة ذواتهم وملامحهم النفسية، كما الخارجية، تجسِّد سعدية؛ بائعة الجبن، تقول: “ترج الرصيف بقدمين صغيرتين، وخطى خفيفة كأنها مس الجان، مرتدية جلابية زرقاء ترتفع قليلا لأعلى بفعل رفْع زراعيها للإمساك بالطشت الألومنيوم، المغطَّى بقماشة بيضاء رطبة، طلبت المساعدة من أحدهم لتضع حملها بجواري، رفعت عينَين تفيض منهما بسمة تناغي شعاع الشمس الساقط على جانب وجْهها المحمر، كأنه أرسل خصيصًا لها، بعد ليلة شتوية عاصفة، ساوَت من وضْع البِنَس الحمراء والخضراء، التي وضَعتها متلاصقة متجاوِرة، تحت مدورة من الفوال الأبيض فوقها الطرحة السوداء والشال الصوفي الأخضر، الذي يحيط بوجْهها الأحمر كما تحيط الكأس ببتلات الوردة، وتجلس كمَن ثبتت في الأرض بمسمارين مفرودة الظهر كإلهة فرعونية، مكتحلة بكحل أزرق يزيد بريق واتساع عينيها.” (ص18)، هذه التفاصيل هي ما تهب القص نبض الواقع والشخصيات، وتعطي للسرد طقسه المتفرد وخصوصيته.