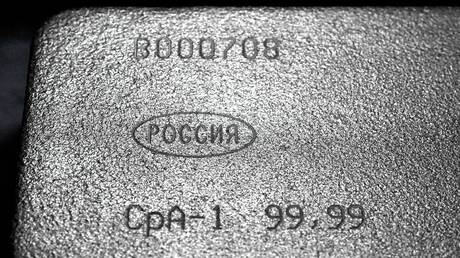بقلم الأستاذة الدكتورة / أماني فؤاد
أتوجَّه في هذا المقال بسؤال جوهري للقُراء: لماذا حدَث هذا التآكُل في الوعي الإنساني التنويري، العقلاني والحقوقي، في الشخصية المصرية (رجُلًا وامرأة)؟ وكيف نخرُج من هذا النفق المظلِم؟
إن ما نَشهده اليوم بصورة عامة ليس مجرَّد رِدة عن مقومات النهضة في عصْر التنوير، في مصر، منذ ثورة 1919 تقريبًا؛ بل أرصد “تغيُّرًا في الوعي والأخلاق”، نتيجة “تسمُّم بيئي” شامل، طال المكونات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والعلاقات الإنسانية، وخاصة علاقة الزواج، وهو ما يمكن حصْر أسبابه في عدةِ مَحاورَ:
أولها الضغوط الاقتصادية، وذلك حين يعجز الرجُل أحيانًا عن القيام بدور ”المعيل” في ظِل تضخُّم كاسح، أو يشتغل بأكثر من عمل بمجهود يفوق طاقته، لكن تَظَل احتياجات أُسرته أكثر مما يستطيع أن يَفِي، وبانشغالاته أو غيابه في سَفره؛ يتلاشى وجوده في منظومة تنشئة الأولاد واحتواء الأُسرة، فتتحول قوامته إلى “تسلُّط تعويضي”؛ ليوَاري شعوره بالعجْز. وفي المقابل، تضطر المرأة للخروج للعمل، بالإضافة لعدم تنازُل المجتمع عن خدماتها المنزلية، فتصبح “كيانًا منهَكًا”، يصارِع في الخارج والداخل، ويرى في الشريك عبئًا لا سَندًا.
وتمتد وطأة هذا العامل الاقتصادي على مستوى الدولة، فعلى مدى عقود طويلة سابقة، أوجَد -انعدامُ التخطيط، والفساد، وتدنِّي موازَنة الخدمات المقدَّمة- بيئةَ العشوائيات والزحام التي استشرت، ثم تحوَّلت من مجرَّد خَلَل عمراني إلى “حالة نفسية”، ثم صارت بُنْية عقليةً عند شرائحَ عريضة من الطبقات. فغياب الخصوصية، والضجيج المستمر، والعيش في مربعات أسمنتية ضيقة، مع منظومة تعليمية تلقينية وتقليدية، وازدحام الفصول، وعدم آدميتها، وانخفاض دخْل المعلِّم وثقافته؛ أفقد الإنسان المصري -الذي كان مقدَّر له أن يعيش تجربة نهضوية واعدة– سواءه واتزانَه وتطوُّر هُوَيته، أفقده عقلانيته ووجدانه الحضاريَّ الثري، المتعدِّد، الموضوعي، واستبدل بها مجرَّد “غريزة البقاء” العنيفة.
في قُبْح العشوائيات وتَبِعات الفقر، يصبح الصراخ والعنف هما لُغة التواصُل، والنِّدية الفَجَّة هي وسيلة إثبات الذات.
ــ وأحسب أن ثاني الأسباب، تجسَّد في تصلُّب الموروث من خلال حارسيه، وصراعه الدائم لمواجهة أيَّة متغيرات ثقافية، تؤسِّس للتطوُّرات الإنسانية الحضارية، فمفكرينا، والقيادات السياسية، والسُّلطة الدينية لم تأخذ التنوير والنهضة على محمَل الجد؛ بل حِلية سطحية تُخرجها وقت اللزوم، فالتنوير الحقيقي يُعلي من العقل البشري، ويجعل الإنسان المحوَر الجوهريَّ، لا يترك -لكل سُلطة راديكالية محافِظة- المساحاتِ الواسعةَ لتسيطر على الوعي بسُلطة النصوص، واحتكارهم للتفسير، التنوير لا يشجِّع الإنسان على السمع والطاعة؛ بل على الفهم ومَنْطَقة القضايا، لا على الاستسلام والصبر؛ بل على الفعل، ولا يشجِّع على انتظار حياة أخرى، والدعاء؛ بل يدعو إلى التغيير في الأرض التي نعيش واقِعَها.


فبدون تفكيك سُلطة الخطاب الموروث: الاجتماعي والديني والسياسي؛ لا يمكن الحديث عن تنوير حقيقي. التطور الحضاري للإنسان يحدُث بعقله، وعِلمه وفِعله، يُصنَع على الأرض، حين نواجه أخطاءنا، ونسعى لحلول لها. لماذا صمْت الجميع طويلا أمام خطابات تبُخُّ التهميش والاستغلال والتسطيح في الوعي العام؟
ــ وأحسب أن أحد أهم أسباب التشوُّه أيضًا، يتمثل في انفتاح أفُق وَهْمِ الحُريات، بعد الانفجار الرقمي، حيث منَحت منصَّاتُ التواصُل الاجتماعي ”حقَّ التعبير” لمَن لا يملك “وعي التعبير”، ولا صلاحية التأثير.
فتحوَّلت المشكلات الزوجية الخاصةُ إلى “تريندات” عامة، واستقى الشباب قِيَمَهم من (البلوجرز)، كما تأثَّر النساء والرجال بالصورة، وبشيوع منظومة الاستهلاك، وأشكال الحياة المترَفة، دون امتلاك مقوِّمات صناعتها، مما عمَّق الهوَّة بين الواقع المرير والتوقُّعات الخيالية.
وتُحِيلنا قضية الحُريات إلى غياب معانٍ وقِيَمٍ وأنظمة فكرية مثل: الليبرالية والديمقراطية، إمكانية التعدُّد، التسامُح مع فِكر الآخَر وقبوله، تداوُل السُّلطة، والمشارَكة في صُنْع القرار، في الوعي المجتمعي، ومن ثم ينعكس هذا الجمود على الوعي الفردي.
(2) وأحسب أنه بخارطة طريق واضحة؛ يمكننا إنقاذ الشخصية المصرية، فحديثُنا هنا لا يشمل محوَر العلاقة بين المرأة والرجُل فقط؛ بل بصفة عامة، ليصُبَّ في وعي منفتِح موضوعي، لكن الخطة التي أقترحها تتطلب تكاتُفًا بين “وعي الفرد” و”أجهزة الدولة”، فلا يمكن للمثقَّف وحْده أن يُصلِح ما أفسده الجهل والفقر وتصلُّب السُّلطات، دون سَنَد مؤسَّسي: نحن بحاجة لتطوير خطاب المؤسَّسات التعليمية والسياسية والدينية، حيث نحتاج إلى خطاب يتجاوَز (فِقْهَ الحَيض والنِّفاس والحجاب والضرب بالمسواك) إلى (فِقه التعايُش والموَدَّة واحترام كرامة المرأة)، (فِقه الطاعة ولعنات الملائكة)، إلى (المشارَكة وتأصيل فن التواصُل)، (فِقه الثبات إلى التطور).
ــ وأن تتضمن المناهج الدراسيةُ مادةَ “التربية الأُسرية”، التي تعلِّم الطفلَ – منذ صغره – أن الرجولة “احتواء ومسؤولية”، وليست “صراخًا وتسلُّطًا”، وأن الأنوثة “كيان مستقِل” وليست “تبعيَّة عمياء”.
ــ كما أؤكِّد للمَرَّة العاشرة أن التدخُّل التشريعي الرادع والمنصِف، يطوي مسافة كبيرة من الطريق؛ بمعنى أنه لابد من قوانين أُسرة عادلة، تضمَن كرامةَ المرأة، دون إهدار حقوق الرجُل، وتقطع الطريق على “الابتزاز العاطفي والمادي”، الذي يمارِسه الطرفان في المَحاكم.
ــ وأرى أن تأهيلَ المُقبِلين على الزواج ضرورةٌ مُلِحة، كالفحص الطبي، حيث يجب أن يكون هناك “تأهيل نفسي وعقلي” إلزامي للمُقبِلين على الزواج، يُشرف عليه مختَصون، لِفَكِّ شِفرات الموروث المشوَّه، وتعليمهم مهارات التواصل وإدارة الأزمات، وإعداد برامج مصوَّرة تناقَش بها تلك الموضوعاتُ على السوشيال ميديا، وتعالَج فيها قضايا الزواج المعاصِر، وأسباب العنف، وكيفية إجراء التواصل بين الطرفَين.
ــ كما لا بد من إدماج “الصحة النفسية” ضمْن المبادرات الرئاسية الكبرى. فالمجتمع يحتاج إلى “جلسات استشفاء” جماعية؛ لمواجهة القلَق والاحتراق النفسي. حيث الوعي الصحي والنفسي أولوية قومية، فتصبح العيادات النفسيةُ في الوِحدات الصحية أمرًا مألوفًا، وليست وصْمة عَار.
ــ كما أن التنمية بكل مناحيها، والنمو الاقتصادي -الذي ينعكس على رفْع دخْل الأفراد- يُوقف الكثير من المشكلات التي يخلُقها العوَز، وهو ما يجعل الطرفَين أقلَّ ضغوطًا وتوتراتٍ، حين تتيسر متطلَّبات الحياة.
الأمان هو البيوت، والبيوت ليست الجدران والغُرف؛ بل تشارك التواصل والمحبة، فإذا أظلمت البيوت بفِعل التسلُّط والهيمنة، أو النِّدية والسَّطحية؛ لن تحتضننا الحياةُ خارج مساحات أماننا الخاص.
نحن بحاجة إلى “مشروع قومي لبناء الإنسان”، يعيد للمصري وعيًا حضاريًّا سمْحًا وراقيًا؛ لنستعيد مفهوم “السكن”، الذي ضاع في زحام العشوائيات والعوز وثقافة التشيؤ.
في النهاية، أطرح بعض النقاط العريضة لـ “مشروع قومي لإعادة بناء الوعي بطبيعة العلاقة الزوجية، للمختصين وصنَّاع القرار، بهدف معالَجة التشوهات، التي طرَأت على الشخصية المصرية:
ــ اعتماد دورات تدريبية إلزامية للمُقبِلين على الزواج، تشمَل (فِقه العلاقات وحقوق الإنسان، الذكاء العاطفي وكيفية التواصل، إدارة الميزانية، ومبادئ التربية الحديثة).
ــ مبادَرة لإنشاء مراكِز إرشاد أُسَري في كل حَي وقرية، تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، تقدِّم استشاراتٍ نفسيةً مجانية، لِفَكِّ الاشتباكات الأُسرية قبْل وصولها للمَحاكم من علماء متخصِّصين.
ــ اقتراح بعض المواد في المناهِج لغَرْس قِيَم التشارُك الأُسري الشامل في الجيل الجديد، مثل مادة “الإنسانيات والتعايُش”، وإدراج مادة تربوية، بدءًا من المرحلة الابتدائية؛ تعزِّز قِيَم المساوَاة في الحقوق الإنسانية، والوعي باحترام الخصوصية، ونبْذ العنف اللفظي والجسدي.
ــ تنقية المناهج من الصوَر النمطية، التي تحصُر المرأة في “الخدمة” والمطبخ وتنظيف البيت ورعاية الأطفال، والرجُل في العمل خارج البيت، والتحكُّم في الأُسرة، واستبدال نماذج “الشراكة والنجاح المتبادَل” في البيت والعمل معًا للطرَفين بكل ما سبَق من مظاهِرَ نمطيةٍ.
ــ تشجيع الإنتاج الدرامي، الذي يبرِز الشخصية المصريةَ نموذجًا إنسانيًّا راقيًا، بدلاً من تمجيد نماذج “البلطجة”، أو الرجُل المِزْواج متعدِّد العلاقات، المتحكِّم. والمرأة الندية أو السطحية، التي لا ترَى خارج حدود رغباتها، أو المرأة التي تقدَّم كسِلعة، ومنْع أساليب الحوار العنيفة والمبتذَلة المجافية لِلياقة والاحترام.
ــ استهداف جيل “التيك توك” و”فيسبوك” بمحتوى توعوي قصير، يقدِّم حلولًا للمشكلات اليومية بأسلوب عصري، ويواجه خِطاب الكراهية والتحريض بين الجنسَين.
ــ تطوير قانون الأحوال الشخصية؛ وذلك بصياغة قانون يوازن بين ”الحماية والمسؤولية”، يغلِّظ عقوبات العنف الأُسري، ويضمن سرعة الفصْل في النفقات والرؤية؛ لتقليل فترات الصراع التي تدمِّر الأطفال، وتفعيل العدالة الناجزة، فكل ما يأتي متأخِّرًا، لا يعوَّل عليه.
ــ تفعيل دور وِحدات مكافَحة العنف ضِد المرأة والطفل؛ لتكون ذات طابع اجتماعي استباقي، لا أمني فقط؛ أي ما يسمَّى بوِحدة الشرطة الأُسرية.
ــ دعْم ريادة الأعمال الأُسرية، وضرورة التمكين، ورفْع المستوى الاقتصادي والمعيشي؛ لتخفيف الضغوط، وذلك بتشجيع المشاريع التي يشترِك فيها الزوجَان، مما يعزِّز لغة المصالِح المشترَكة، والتعاون بدلًا من الصراع المادي.
ــ وضْع حوافز للأُسر المستقِرة، بتقديم مزايا عَينية أو ضريبية للأُسر التي تلتزِم ببرامج التوعية والتدريب، كنوع من التشجيع المجتمعي.
ــ تفكيك الموروث الجامد، بتكليف المؤسَّسات الدينية؛ (الأزهر والكنيسة) بإصدار وثيقة “حقوق الشرَاكة الإنسانية”، التي تفنِّد التفسيراتِ الخاطئةَ لآيات القوامة والطاعة، وترسِّخ لمبدأ “وجعل بينكم موَدَّة ورحمة”.
ــ تشجيع الحراك الثقافي، وبَلْوَرة خطابات متخصِّصة أخرى لعلماء الاجتماع، وعِلم النفس والمفكِّرين، للسياسيين والإعلاميين وصانعي المحتوى القَيِّم، فالخطابات المتعددة تفتح الأفق الإنساني على الرؤى الأشمل.