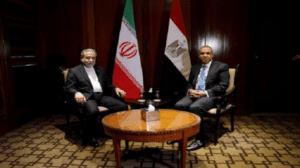بقلم دكتورة / أماني فؤاد / مصر
في عام 1986 يتحدَّث أبي بشغَف عن مسرحية (إيزيس)، التي ستُقدَّم على المسرح القومي بالقاهرة، يعِدُنا بأنه سيصحَبنا لمشاهدتها، فتسرَح خيالاتي محلِّقة؛ سأرى (توفيق الحكيم)، وألمِس عصاه الشهيرةَ والبيريه، حماره وأهل كهفه، ربما سيكون بصُحبته سلطانه الحائر أو شهرزاد، رباطه المقدَّس، وفتاة التذاكر الفرنسية الفاتنة، وشوارع باريس ومقاهيها ومتاحفها، وشمس الفكر، تخيَّلت أنني سأراه رؤية العين، قامة سامقة في صحبة عوالمه الثرية، التي صنعها بمؤلفاته، هي عودة الروح التي انتعشَت بأمل مقابلة هذا الكاتب العظيم، الذي صحبتُ مؤلَّفاتِه طويلا؛ فتعلَّمت فلسفة السؤال، والغوص في المعاني والقضايا.
لم يكن الحكيم في كل كتاباته باحثًا عن المألوف، أو مجرَّد الوجود، فحين شغفَ بالمسرح قبْل سَفره، وأثناء فترة بِعثته في فرنسا، عاد إلى مصر 1928؛ ليكتب المسرح النثري العربي ناضجًا في نَصِّه “أهل الكهف”، الذي عالَج فيها فكرة الزمن بتغيرات مراحله، وتأثيره على الإنسان، ثم تلاها بأكثر من ثلاثين مسرحية نثرية، وهو ما جعَله رائدًا يتمتع بالجرأة على ترسيخ المختلف على الساحة الأدبية في ثلاثينيات القرن العشرين، فلقد صدرت “أهل الكهف” ورواية “عودة الروح” عام 1933.
وبالرغم من الإنتاج المسرحي الغزير للحكيم، إلا أن عددًا قليلاً من هذه المسرحيات يمكن تمثيلها علي خشبة المسرح ليشاهدها الجمهور، وبقيت معظم مسرحياته من النوع الذي يُطلَق عليه (المسرح الذِّهني)؛ أي نصوص مسرحية كُتبت لتُقرأ، بنية حوارية تستند على الأفكار التي تتجادل، عالَم من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع في سهولة ويُسر؛ لتُسهم في تقديم رؤية نقدية للحياة والمجتمع، تتسم بقدْر كبير من العمق والوعي.
قال عن مسرحه الذِّهني: (إني اليوم أُقيم مسرحي داخِل الذِّهن، وأجعل الممثلين أفكارًا تتحرك في المطلَق من المعاني مرتدية أثواب الرموز.. لهذا اتَّسعَت الهُوَّة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقُل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة).
كان لتوفيق الحكيم في كتاباته بتنوُّعها قُدرة على المزْج الفريد بين الواقعي والرمزي، قُدرة على مناقشة الأحداث اليومية التي تشغَل الفرد، والارتفاع بها في حركة من تصاعُد الأسئلة وتوالُدها؛ إلى طرْح ومناقشة القضايا الوجودية الكُبرى، التي تشغل البَشر، مثل العلاقة بين الحاكم والمحكومين وأساليب الحُكم في “عودة الروح”، أو المفاهيم الاجتماعية التي تحكُم العلاقة بين الرجُل والمرأة في “الرباط المقدس”.
ولأسلوب توفيق الحكيم قُدرة على جذْب قارئه، ودمْجه في القضية التي يُناقش أبعادها بلا تعقيد أو غموض؛ بل بسلاسة في عرْض الدراما (الصراع) وزواياها المختلفة، ساعَده تمكُّنه من توظيف الخيال والأساطير والرمز في طيات أحداث الواقع العادية. يقول الحكيم واصفًا الخيال: “الخيال هو ليل الحياة الجميل، هو حصننا وملاذنا من قسوة النهار الطويل! إن عالَم الواقع لا يكفي وحدَه لحياة البَشر، إنه أضيق من أن يتَّسع لحياة إنسانية كاملة”.
اعتمد الحكيم في بنية نصوصه – سواء الروائية أو المسرحية – على الرمز وقصص التاريخ الموروثة وشخصياته، على الأساطير، فلقد درَس المسرح اليوناني بحبْكته وأساطيره؛ حين عرَف أنه أصْل المسرح الأوربي الذي شغف به، وظَّف الأساطير برؤية خاصة، وبحَث عن الأساطير الفرعونية التي تُميز هُوَيتنا، قال في توظيفه لأسطورة إيزيس: “ليس المقصود هنا تصوير الحياة الفرعونية، أو بسْط العقائد المصرية القديمة؛ بل المقصود… إبراز شخصيات الأسطورة إبرازًا جديدًا إنسانيًّا، وتخريج معناها على المفهوم الحي في كل عصر وفي العصور الحديثة على الأخص.” في “إيزيس” – التي كُتبت في الخمسينيات – أراد الحكيم أن يناقِش، هل على المواطن العادي أن يشترك ويتفاعَل مع أحداث بلده، أم يقتصر دوره على المراقبة من بعيد، فهو الذي قال: “إنك تفترض أن الناس جميعًا قابِلون أن يكونوا أحرارًا، وننسى أن أغلب الناس لا يستطيعون، ولا يريدون أن يكون لهم رأيٌ.. إنما يستسهلون ارتداء الآراء التي تُصنع لهم صُنعًا.” وتأثَّر الحكيم أيضا بكتاب الموتى الفرعوني، والقرآن الكريم، والفلكلور الشعبي المصري، والعربي، أراد أن يُثري عوالِمَ نصوصه المسرحية بروافدَ مختلفةٍ من طبقاتنا الثقافية المتنوعة، في تناصَّات مختلفة المصادر والحضارات، التي انصهرت في كيان الشخصية المصرية الاعتباري، استهدف أفكارًا لتصل قرَّاءه؛ ولذا يتبدَّى حرصه في نصوصه كلها على المعنى الواضح، وعدم المبالغة أو الإغراق في الغموض؛ فلديه رسالة تتطلع لإيقاظ الوعي، في فريدته الرائدة (عودة الروح)، التي أثَّرت في كل أجيال الكتاب من بعده، يناقش الحكيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين، ويدمج تاريخ حياته في الطفولة والصِّبا بتاريخ مصر، فيجمع بين الواقعية والرمز والأسطورة في شخصية “سنية”، التي تتقاطع مع شخصية إيزيس.
وللحكيم قُدرة فائقة على ابتكار الشخصيات، وتجسيد أبعاد خاصة بها ببراعة فائقة، رسم أبعادها بحيوية للدرجة التي تُشعرك أنها تتحرك وتتحدث بجوارك، شخصيات ثرية بأفكارها وصراعها مع الوجود من حولها، بالإضافة إلى قُدرته على تنوُّع مستويات الحوار؛ بما يناسب كل شخصية وثقافتها وطبيعتها، ويتَّفق مع مستواها الفكري والاجتماعي.
كما استطاع في أعماله المسرحية تفادي المونولوج المحلِّي، الذي كان الطابع الغالب على الدراما المصرية قبْله، وفي الوقت ذاته لم يبتعد عن تجسيد البيئة المصرية بوضوح؛ من خلال قُدرته على تصوير مشاكل المجتمع المصري في ذلك الوقت، وهو ما يشهد بتمكُّنه ووعْيه، وبما طوَّعه من حصيلة لغوية ثرية؛ تمكِّنه من نقْل نماذج شخوصه المتباينة، التي جسَّدت مراحل تاريخية مختلفة. كما يمتاز أسلوب توفيق الحكيم بالدِّقة والتكثيف الشديد، وحشْد المعاني والدلالات الثرية، وإبراز فروقها الطفيفة، والقدرة الفائقة على التصوير؛ ففي جُمل قليلة يحشد من المعاني ما قد لا يبلغه غيره في صفحات طوال. كما يعتني عناية فائقة بدِقة تصوير المشاهد، موظِّفًا لمتطلبات المسرح الذي يُشاهَد بالعين، أي بحشْد أدق التفاصيل، والحرص على تجسيد حيوية الحركة، أما فيما يتعلَّق بوصْفه للجوانب الشعورية الداخلية، والانفعالات النفسية؛ فلقد برَع الحكيم في الغوص في العمق البَشري، وكهوفه وتناقضاته وضَعفه وقوَّته، وهو ما يُنبئ بوعي وثقافة نفسية متبحرة، وتأمُّل ناصع للوجود البَشري.
يقول نُقاد الحكيم: إن كتاباتِه مَرَّت بثلاث مراحل:
الأولى: جاءت عِباراتُه قليلة، فضفاضة إلى حدٍّ كبير، ومن ثم فقد لجأ فيها إلى اقتباس كثير من التعبيرات السائرة لأداء المعاني التي تجُول في ذِهنه. وفي هذه المرحلة كتَب مسرحية: أهل الكهف، وقصة عصفور من الشرق، وعودة الروح.
في المرحلة الثانية بحَث عن التطابق بين المعاني في عالمها الذهني المجرَّد، والألفاظ التي تعبِّر عنها من اللغة، فجاءته مطواعة بشيء من التدرج، ثم التمكن من الأداة اللغوية والإمساك بناصية التعبير الجيد. وهذه المرحلة تمثِّلها مسرحيات شهرزاد، والخروج من الجنة، ورصاصة في القلب، والزمار.
في الثالثة تجلَّت قُدرته على صياغة الأفكار والمعاني بصورة سلسة جيدة. وخلال تلك المرحلة ظهر العديد من مسرحياته مثل: سِرُّ المنتحرة، نهر الجنون، وبراكسا، وسلطان الظلام.
ولا ترجع أهمية الحكيم إلى كونه مبدع (أهل الكهف) – أول مسرحية عربية ناضجة بالمعيار النقدي الحديث – فحسب، وصاحب رواية (عودة الروح)، التي يحكي الكثيرون إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد تمثَّلها، وأثَّرت في وعْيه العميق، وخطَّ بقلمه تحت سطور وعبارات منها؛ فألهَمته – بشكل أو بآخَر – في تخطيطه وقيادته لثورة يوليو 1952.
كما تتبدَّى أهمية الحكيم في استلهامه صفحات وشخصيات من التراث المصري في الأعمال المسرحية والروائية، سواء الفرعوني أو الروماني أو القبطي أو الإسلامي، كما أنه استمد أيضًا شخصياتِه وقضاياه المسرحيةَ والروائية من الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي المعاصر لأُمَّته.
ومن أشهر مسرحيات الحكيم الذِّهنية مسرحية “محمد”، و”بِجماليون”؛ والأخيرة معالَجة فنية لأسطورة إغريقيَّة حول شخصية “بِجماليون”، الإنسان الذي لا يرضَى بأيِّ حال من الأحوال، فلقد ضاق بتمثال المرأة الذي قام بنحْته؛ لأنه لا يتحدث معه ولا يحاوره، فطلَب من القوَى العليا يسبِغ عليها الحياة، وحين دبَّت فيها الدماء؛ عاد وضاق من الآخَر الذي تجسَّد فيها.
ولقد تميَّز توفيق الحكيم بشَغفه في تجريب التيَّارات الأدبيَّة المُختلِفة، يرى دكتور مندور أنَّ الحكيم عَمِل على تطوير أسلوبه في الفنِّ المسرحيِّ ضِمن ثلاث مراحل، مرحلة مسرح الحياة: وهي المرحلة الكتابيَّة التي تقَع بين فترة (1943-1951)م، حيث تمَّ جمْع مسرحيَّات الحكيم فيها ضِمن سلسلتَين، وهُما: “مسرح المُجتمع”، و”المسرح المُنوَّع”، وكانت هذه المسرحيَّاتُ تتطرَّق إلى السلوكيَّات الاجتماعيَّة، والأخلاقيَّة، وتُورِد رأيُ الحكيم في الحياة الاجتماعيَّة. ومرحلة المسرح الذِّهنيِّ: تتضمَّن هذه المرحلة في حياة الحكيم الكتابيَّة الأفكار الذِّهنيَّة التي نُوقِشت بطابع دلاليٍّ، بالإضافة إلى اعتماده التَّجريد في النَّص المسرحيِّ، بدلًا من الصِّراعات المادِّيَّة، ومن المسرحيَّات التي تتناوَلها هذه المرحلةُ: مسرحيَّة “أهل الكهف”، ومسرحيَّة “شهرزاد”، ومسرحيَّة “بِجماليون”. مرحلة المسرح الهادف: تتناوَل هذه المرحلةُ النُّصوصَ المسرحيَّة، التي ألَّفها بعد عام 1952م، وتحمِل رُوحًا وفلسفة جديدة في فِكر الحكيم، فقد عمِل على تأكيد فكرة القيادة في الحياة من خلال إسقاطها على نَصٍّ دراميٍّ، وهذا على خلاف السَّابق من إظهاره لحقائق الحياة، ونقْده لأحداثها، ومن الأعمال المسرحيَّة للحكيم في هذه المرحلة: مسرحيَّة “الأيدي النَّاعمة”، ومسرحيَّة “الصَّفقة”، ومسرحيَّة “أشواك السَّلام”. كان للحكيم تعريفُه الخاص لمسرح العَبَث؛ فكان يعتبر مسرحَ اللامعقول محاولَةً لاستكشاف التلاحم بين المعقول واللامعقول في تفكير الإنسان الشرقي.
كما اشتُهر توفيق الحكيم – على مدى تاريخه الطويل في المشهد الثقافي المصري – بنسْج الحكايات من حوله، فتارة هو عدو المرأة، المُضرِب عن الزواج، الذي يرى في جمال المرأة التعويض الوحيد عن سطحيتها، رغم إنه من أهم الكُتاب الذين تناولوا قضايا المرأة والمجتمع بحُرية وعقلانية؛ لإبراز الغُبن الذي يقع عليها ضمن التقاليد والمفاهيم الاجتماعية والثقافة الذكورية. وتارةً أخرى يروِّج أصدقاؤه لبُخْله، ويقُصُّون المواقف متندِّرين، في حين يقول عنه نجيب محفوظ: إنه لم يبْخَل بكلِّ ما يملك على أخواته وابنته. لكن يبقَى – الذي لا يعتريه الشكُّ – أن الكاتب والمفكر الذي أنتج كل هذا الإبداع في الفكر والفن، وتحريك الراكد في الحياة الثقافية المصرية والعربية، لا يمكن أن يتَّصف بالبُخل.
كما اشتُهر الحكيم بمعاركه الفكرية، التي خاضها أمام ذوي الاتجاهات الفكرية المخالفة له؛ وكانت آخِر معارك الحكيم الفكرية مع الشيخ الشعراوي، ذلك عندما نَشَر الحكيم على مدى أربعة أسابيع ابتداء من 1 مارس 1983 سلسلة من المقالات بجريدة الأهرام بعنوان “حديث مع وإلى الله”.