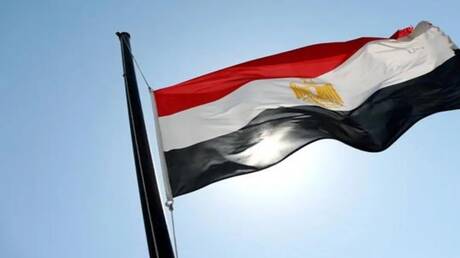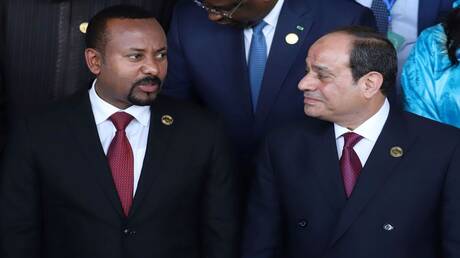بقلم : صلاح سالم
يتوزع الإسلام السياسي على تقليدين رئيسيين يختلفان كثيرا فى الحجم الديموجرافى و الامتداد التاريخي : الأول سنى هو الأكثر عددا و الأوسع انتشارا فى أربعة أنحاء العالم الإسلامي الممتد حول القلب العربي و يرتبط بنظرية الخلافة ، و الثاني شيعي هو الأقل عددا و انتشارا و يرتبط بنظرية الإمامة التي انبثقت عن المذهب «الاثنا عشري».
كانت نظرية الخلافة حاضرة بالفعل طوال التاريخ تفاعلت معه و تطورت فيه ، و تأثرت بخشونته مثل سيارة تتحرك على أرض مليئة بالكثبان الرملية ، أما نظرية الإمامة فظلت أقرب إلى يوتوبيا سياسية ذات طابع خلاصي ، و تقوم على عقيدة المهدى المنتظر ، كانت حركتها فى التاريخ أقرب إلى طائرة فى الفضاء ، تطل عليه من فوق و من بعيد من دون اصطدام مباشر معه.
نعم عانى الأئمة خصوصا الحسين خشونة سياسية نالت من دمائهم ، و لكن كأفراد معارضين لسلطة قائمة ، أما النظرية نفسها فلم تتجسد واقعيا وإن تم توظيفها لخدمة تطبيقات محدودة فى أزمنة متأخرة نسبيا ، و يأتي على رأسها الدولة الفاطمية فى مصر و شمال إفريقيا فى قلب العصر الوسيط ، و الدولة الصفوية فى قلب الجغرافيا الإيرانية مطلع العصر الحديث.
اليوم نجد أنفسنا أمام مفارقة ، حيث حضر الغائب و غاب الحاضر ، لقد عادت الإمامة الشيعية إلى التاريخ عبر صيرورة تطور تدريجي من ميثولوجيا دينية يؤطرها مفهوما : الغيبة و الانتظار إلى مفهوم سياسي حكم إيران فى القرن العشرين ، حيث مارس كبار الأئمة من آيات الله نشاطا سياسيا فى مواجهة طغيان الأسرة القاجارية ، تبدى واضحا فى أجواء الثورة الدستورية 1906 ـ 1911م ، قبل أن تزداد معارضتهم للأسرة البهلوية و يتمكن الولي الفقيه / الخميني من إسقاط حكم الشاه محمد رضا فى فبراير 1979م و صياغة نظام حكم ثيوقراطي يجمع بين الحقيقتين : الباطنية التي يتلقاها عن الإمام الغائب ، و السياسية التي حازها بقوة الثورة الإسلامية.
و هكذا يستدعى الولي الفقيه من الذاكرة التاريخية ، صورة البابا الكاثوليكي المعصوم ، ذروة الهيمنة الكهنوتية على السلطة الزمنية فى العالم المسيحي ، لم تكن الثورة الإيرانية إسلامية خالصة بل كانت شعبية ذات دوافع اجتماعية و اقتصادية و سياسية ، كالثورة الروسية التي لم تكن بلشفية بل شعبية.
و كما نجح الحزب البلشفي فى الاستئثار بالسلطة و تصفية الخصوم ، و انتهت الثورة الإيرانية بنجاح التيار الديني فى إقصاء منافسه المدني ، قبل أن يتمكن الحزب الجمهوري الإسلامي بالذات من تصفية باقي القوى الإسلامية التي تحفَّظت على استئثار الولي الفقيه بالسلطة.
و فى المقابل بدأت نظرية الخلافة رحلة غيابها بانهيار السلطنة العثمانية 1924م ، فلا تكاد توجد اليوم دولة تحكم رسميا باسم نظرية الخلافة ، و إن وجدت أحزاب و تيارات سياسية تتبنى أيديولوجيتها ، سواء من موقع المشاركة فى الحكم و لو نادرا ، أو المعارضة الشرعية أحيانا ، أو الانقلابية ضد الأنظمة السياسية القائمة فى أغلب الأحيان ، و على رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
و هنا يكمن فارق أساسي بين السنية السياسية و نظيرتها الشيعية ، إذ لا تواجه الأخيرة حركات انقلابية تذكر بعد أن بسطت قبضتها على الدولة الإيرانية ، نسجا على منوال الحركة الصهيونية التي أنشأت إسرائيل كدولة دينية ، ففي الحالتين تمت استعادة الدولة من رحم التاريخ باسم فكرة ميثولوجيه ، و إن كانت شيعية مهدوية هنا و يهودية مشيحانية هناك.
و رغم تلك الاختلافات بين النظريتين فإن أمرا أساسيا يجمع بينهما و هو سقوط الإنسان كفرد من قائمة انشغالاتهما ، نعم يبقى الإنسان حاضرا كمسلم يتلقى التكاليف ، كإحدى الرعايا الذين تمُارس عليهم السلطة ، و لكنه غير موجود كفرد حر ، شيعيا لأن شرعية الاختيار البشرى مرفوضة من حيث المبدأ ، فالإمام الذى يتلقى الحقيقة من أفق الغيب لا يمكن لبشر أن يحاسبه.
و رغم اعتراف الخميني بأن الفقيه لن يكون على مستوى الرسول و الأئمة ، فإن معرفته بالقانون الإلهي تعنى أن باستطاعته أن يمتلك نفس سلطتهم ، و أن يرأس مجلسا يشرف على تطبيق الشريعة بدلاً من وجود مجلس نيابي يأتي بتشريعات وضعية.
و هكذا أصبحت مسئوليته أمام الله وحده ، فلا يحلف اليمين أمام أي سلطة ، و لا يشرح موقفه لأى شخص ، و لا يخضع لمراقبة أي مؤسسة فى الدولة بل هو المسئول عن مراقبة مؤسسات الدولة ، أما سنيا فلأن الاختيار البشرى منوط بعدد محدود من أهل الحل و العقد ، حيث لا معنى للقول بأن الأمة هي مصدر السلطة تمارسها من خلال وكلائها لأن أهل الحل والعقد ليسوا منتخبين كي تكون لهم تلك الصفة التمثيلية.
و فضلا عن ذلك ثمة حقيقتان : الأولى هي أن أهل الحل و العقد كانوا دوما من جسم اجتماعى لصيق بالسلطة القائمة ، و مكانتهم الاعتبارية تنبع من هذه الصلة ؛ فلا أحد غير الخليفة يستطيع أن يسميهم و يمنحهم حق النطق باسم الجماعة ، رضيت بهم الجماعة أم لم ترضي ، أما الثانية فهي أن دورهم كهيئة مختارة لها قدر من الاستقلال على الطريقة التي صاغها عمر بن الخطاب لاختيار خليفته ، و لم تتكرر كثيرا ، حيث حل محلها دائرة وظيفية من فقهاء الدولة الرسميين الذين كثيرا ما كانوا فى الأغلب علماء سلطان.
و على هذا تقصر النظريتان عن تجسيد أي ضوابط لمفهوم الشرعية السياسية ، ناهيك عن مفهوم الحرية الإنسانية ، الذى ظل مقصوراً على الوعى الإسلامي إما على المعنى الأنطولوجي الكامن فى التداول القرآني الذى يرسم حدود حرية الإنسان فى مواجهة عقيدة القضاء و القدر، حسبما فهمتها و تجادلت حولها الفرق الكلامية.
و إما على المعنى الاجتماعي الذى انعكس فى الاستعمال الفقهي كمجرد نقيض لحالة العبودية ، فالإنسان الحر هو فقط غير المملوك لغيره ، أما المعاني الحديثة للحرية التي تمنح الإنسان كذات فردية لها حق امتلاك مصيرها و السيطرة على وجودها ، و التمتع بمجموعة من الحقوق الأساسية كحرية الاعتقاد و التفكير و التعبير و الاختلاف و التنظيم فظلت غائبة عن تاريخنا.