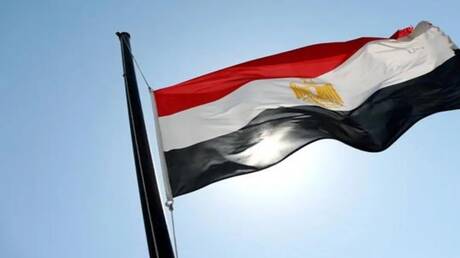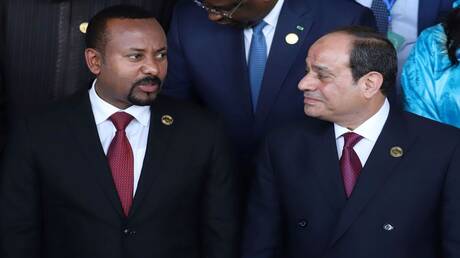بقلم صلاح سالم
أسلفنا القول بأن تواري سحر الغيب القائم في الإيمان الروحي، وسحر الميتافيزيقيا القابع في المثل العليا الإنسانية للفلسفة التأملية قد أفقد العالم بكارته حتى لم يعد فيه ما هو مثير وطازج، يثير الفضول والتألق والتوهج، حيث افتقد الإنسان إلى الهدوء والانسجام والسلام النفسي، وأيضا إلى الخيال والجمال، إلى ورود يشم عطرها دون أن ينزع أوراقها بحجة تحليلها، إلى مصدر للطاقة النفسية يروى ظمأه للمعنى ويجدد شغفه بالوجود. وكذلك إلى التعاطف والتراحم والتضامن، إلى قلب يحنو عليه بلا ثمن، ويد تسنده عندما يكبو على قدميه وترفعه قبل أن يهوي على وجهه. ومن ثم ولدت نزعة تاريخية نقيض لإعادة بث السحر في العالم، لكنه ليس السحر القديم القائم في الدين والميتافيزيقيا بل سحر جديد لا يهبط من أعلى بل ينبثق من أسفل، من تمجيد النشاطات الدنيوية وإضفاء معان قدسية عليها كي تصبح مصدرا للتشوه لدى الأفراد، وجذرا للتضامن الفعال داخل المجتمعات.
سر حاجتنا إلى ذلك هو توق الإنسان الدائم إلى التعالي والتسامي، إلى معنى فائق يتجاوزه ليستطيع أن يلهمه. ولأن العالم العلماني يرفض أن يكون المعنى نابعا من تعال مطلق يفترض الحضور الإلهي فى الكون، فقد تعين علي أربابه القيام بصناعة مصدر وضعي للتعالي، ينبع إما من روافد مثالية تعلو على حركة اليومي والعادي، تحقق له الشعور بالسمو ولكن من داخل الحيز الإنساني نفسه، تشعره بأصالة الانتماء إلي العالم سواء كانت مفاهيم نظرية من قبيل النزعة الإنسانية، وأنساق سياسية كالدولة الوطنية، أو من خلال نشاطات عملية قادرة على إشاعة النشوة النفسية لدى جمهورها الذي يشارك فيها كعبادة طقسية وإن دنيوية، تجمع بين مؤمنين محدثين لا يرغبون في تقديس إله واجب الوجود رغم استعدادهم لتقديس ما دون الإله.
في هذا السياق تزدهر الطقوس الرياضية، خصوصا مباريات كرة القدم، حيث يحتشد بشر كثر في مكان واحد، ينتظرون ساعات طويلة لمشاهدة لاعبين يتنافسون بإصرار غالبا وعنف أحيانا، توقا إلى التفوق دائما، فتتعالى الأصوات بالمديح والهجاء، وتلتهب الأيدي بالتصفيق من قبل شخص أنفق ماله ووقته للشعور بنشوة الانتصار أو مجرد المشاركة في طقس جماعي مع الآخرين، ذهابا إلى الملاعب وعودة منها، وكأنهم في رحلة حج بديلة عن طقوس الحج المعروفة في جميع الأديان، يقوم بها أناس فقدوا القدرة على الشعور بنشوة المقدس الديني لكنهم لم يفقدوا الحاجة إلى لاصق روحي يضمن لهم التلاحم والتفاعل معا، يخلق معنى مباشرا لحياتهم بديلا عن الغائية الإلهية لوجودهم. كما تزدهر الطقوس الفنية: المهرجانات السينمائية، معارض الفن التشكيلي، المسارح الكبرى، خصوصا فن الرقص، كطقس نفس ـ جسدي يشعر القائم به بنوع من الذوبان يزول معه الحاجز بين مكونه المادي ومكونه الروحي، فيتبادل الطرفان التأثير ويدفع كلاهما الآخر إلى حالة انتشاء أعلى تشبه حالة النيرفانا البوذية. غير أن الرقص كطقس فني لا يهدف، عكس التنسك البوذي، إلى فناء الجسد، بل إلى ضمان تناغمه مع الروح، ليكتسب هو خفتها ورشاقتها، وتكتسب هي حضوره وفعاليته.
ولكن، هل يعنى ذلك أن لا مشكلة، حيث حل المقدس الوضعي محل المقدس الديني وانتهى الأمر؟. ليس كذلك. أولا، لأن المفاهيم والطقوس التي تمنح المعنى الدنيوي متغيرة ونسبية بطبيعتها، يصنعها البشر أنفسهم، وتختلف صورها حسب ثقافاتهم. بل إنها كثيرا ما خلقت مشكلات أكثر حدة من المشكلات التي تصدت لها بفعل الغرور والغطرسة البشريين، إذ من الخطير جدا أن يشعر الإنسان بأنه خالق لكينونات أو رب لأنساق، فحينذاك إما أن يسعي إلى استغلالها بأنانية، وإما يمنح لنفسه حق تدميرها. فمثلا، كادت النزعة القومية المتطرفة كما تجسدت في النازية والفاشية تحيل العالم إلى حطام باسم ذات وطنية متضخمة جرى النفخ فيها بعنف. أما الطقوس الرياضية والفنية فسرعان ما وقعت أسيرة للرأسمالية التي قامت بتسليعها وتشفيرها وجعلت من رموزها كهنة معبد جدد، يقوم ملايين الناس/ الجماهير بتقديم القرابين إليهم لأجل الفرجة على طقوسهم، سواء في الملاعب المفتوحة أو الصالات المغلقة. وثانيا، لأن ما يلهم الإنسان لابد أن ينبع من مصدر سام. نعم يستطيع المقدس الدنيوي أن يمنح للإنسان بنية نفسية تشغل أوقاته وترتب له نشاطاته اليومية وتجمعه في علاقة أفقية مع الآخرين، لكنه لا يستطيع توفير جسور تواصل رأسي مع الكائن القدسي، الخالق الرحيم، الذي يفتح سقف الوجود على الأعلى كي يمنح العناية لمخلوقه الأسمى، ويلهمه معنى لحياته ومغزى لمصيره.
من تلك فجوة القداسة هذه، الكامنة بين تدنيس المقدس وتقديس الدنيوي، ولد ثقب أسود في جدار الحضارة المعاصرة، أخذ ينمو ويتسع حتى بات التشوش واضحا على كل أصعدة الفكر والوجود: بين مسيرة تقدم العقل على طريق المعرفة وبين ادعائه القدرة على بلوغ اليقين. بين أن يتحرر الإنسان حقا من أسر الوصاية الكهنوتية باسم الإله وبين أن يفرض وصايته هو على الإله. بين أن يتجاوز الإنسان اغترابه في التاريخ ليصبح إيجابيا، قادرا على الفعل فيه والتأثير في حركته، وبين أن يدعى امتلاك التاريخ متوهما القدرة على التحكم في مساراته المستقبلية بدقة متناهية، أو الحق في إنهائه تماما في أي لحظة زمنية. بين أن يمتلك الإنسان التكنولوجيا ليرى ما هو أدق وما هو أبعد، أو ليحرر نفسه من قبضة الحواس وأسر العبودية الخشنة، وبين أن تمتلكه التكنولوجيا، فتصير سيفا مسلطا على رقبته، تمارس ضده جل طقوس الغواية وكل صنوف الإرغام، وصولا إلى العبودية الطوعية لمجتمعي الاستهلاك والفرجة، على النحو الذى نشهده اليوم!.