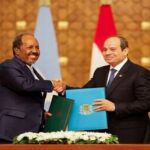بقلم دكتورة / أماني فؤاد
1_
في تنوُّع ثري من الشخصيات التي تنتمي لعائلة واحدة، ذات أصول وامتدادات تاريخية، تصِل لأشراف بيت النبوة، يشكِّل الروائي (أحمد القرملاوي) سردًا دراماتيكيًّا لأكثر من ثلاثة أجيال في روايته “ورثة آل الشيخ”، التي نالت جائزة كتارا عام 2021، فيحكي عن جدِّهم الأكبر الشيخ حسن الأزهري، الذي كان يُلهب حماس الناس لمقاومة الجيش الفرنسي وقائدِه بونابرت، وكيف أن الأخير حبَسه وغرَّمه كل أمواله؛ ليكُف عمَّا يفعل. ثم شارَك الجد في عزْل خورشيد، وتنصيب محمد علي؛ وأكرمه الوالي الجديد بالأموال والمناصب، حتى صار بالِغ الثراء.
يسوق الروائي في نَصه الكثيرَ من تغيُّرات الأقدار المفاجئة، تلك التي تقَع على شخصيات نَصه، وتبدِّل حياتَهم بطريقة خاطفة، وقائع فارقة تميل إلى الميلودراما، وتشمل أولاد وأحفاد الجد الكبير، فبَعد الحرب العالمية الأولى، يترك “صدقي الحكمدار”؛ الابن الأكبر للجد “الشيخ”، وظيفتَه في الشرطة المصرية في أوج تحقُّقه وقوَّته، ثم ما يلبث وأن يُقتل، يولد حسن؛ ابنه، بمرض ضمور العضلات، ويصبح معاقًا، ثم يُقبض عليه بعد سنوات في واقعة تزوير نقود، في مطبعة أخيه حسين، ويموت في الكاراكول، تُطلَّق نعمات، وتُهان بالضرب من زوجها لساديته، وهي لم تَزَلْ عروسًا، لم يمُر شهران على زواجها، يموت شاهر زوج زبيدة، وهما في أوج سعادتهما، يفقد محمد إحدى عينَيه وحبيبتَه التي حلم بها، وهو يستعد لدخول الشرطة وتحقيق حلمه، يتكسَّر جسد نشأت ضابط الجيش في الحرب، ثم يفقد ليليت؛ الأرمينية التي أحبَّها وسكَن – من أجْلها – مدينةَ بور سعيد، وهكذا تنمو الكثير من مصائر الشخصيات بفواجعها، التي تقلِب حياةَ كلٍّ منهم رأسًا على عقب، أو تقع بعض أوراق الشجرة تمامًا.
وبالرغم من كل هذه القصص الدرامية، تتبدَّى سِمة مميزة للسرد في هذا النَّص، فتَحْتَ تروس الحياة الضخمة – التي لا تقبل التوقف على حال – يجسِّد الحكي، بتقنياته السردية التي تنسج شبكة العلاقات القدرية، ضرورةَ تكيُّف البشَر مع المستجَدَّات، وعيش الحياة بكل صُورها، حيث من الممكن أن يوجد بديل لكل شخص قد غادَر، ولكل حلم قد تبدَّد، فالحياة لا تقِف من أجْل أحد، ولا يعوقها حدَثٌ مهما عظُم وقْعه. فتلك بعض سِمات السرد، الذي يحاكي فلسفة الحياة وطبيعتها المتغيرة، كأنه يومئ للإنسان بضرورة تقبُّل الأقدار واستمرار التعايش مع تغيرات الزمن، تحت أيِّ ظَرف.
2ــ
ويدفع الكاتب في نسيج سرديته بخيوط من سِحر شفيف غامض؛ ليضع الواقع بشكل ما ضِمن العجائبي، حيث التاريخ الممتد لشجرة العائلة منذ الرسول والصحابة، فيهَب بعض القداسة لأصول العائلة، كما يُلحِق بيت العائلة – الخرنفش الذي يشهد الأحداث وتوالِي الأجيال – بهالة من التبجيل؛ حيث يقع في منطقة الجمالية الأثرية، بجوار الدار التي تخرُج منه كسوة الكعبة كل عام، ويشهد أهلُه تلك الطقوسَ، ويشاركون فيها، كما يضيف للبيت طقسًا سحريًّا، لارتباطه بحلم وأسطورة القِرد الذي يحرس الكنز، المكوَّن من السبع زَلْعات الممتلئة بالذهب، وهو ذاته البيت الذي اختفت أوراق ثبوتية ملكيته، ومهما امتدَّ بحْثُهم عنها؛ لا يجدوا لها طريقًا. تلك العوالم الفنية، الأسطورية، والدينية المُضغَمة والمنغرِزة في الأحداث، هي التي تدفع بمساحات لشغف القارئ بالنَّص، كما تهَبه هالةً من الغموض.
يقول الراوي: “في البيت الكائن في شارع الخرنفش بحي الجمالية، وُلِد أبي. إنه البيت الذي بناه جدُّنا الشيخ سليل الأشراف، صادِق الرؤيا، مع بداية عصر الخديوية، حتى تستقل كل زوجة من زوجاته الثلاث في جناح من أجنحته، ..، حيث يُطل شبَّاكها على الأرض الفضاء المتاخِمة للبيت، والذي تفصله عن دار كسوة الكعبة، الذي تُصنع فيه الكسوة الشريفة بأنَاةٍ وصبْر طوال العام، حتى تنتقل في موسم الحجيج مع قافلة الجِمال يؤمُّها هودج، يقال إنه يعود لزمن السلطانة شجرة الدر..”27، 28، ويسبق وصْفَ المكان وصْفُ معمار المنزل، الذي يضاهي البيوتَ ذاتِ المعمار المملوكي التراثي.
ينطلِق سرْد الرواية بدايةً من قراءة الضابط لمخطوطة للنَّص الروائي، الذي يكتبه أحمد، والتي كانت موجودة معه حين قُبض عليه هو وأبيه، حيث تُروَى مخطوطة النَّص بصوت أحمد، الذي يريد أن يقُص سرديته الخاصةَ وتاريخَ عائلته، تنازعه نفسه حائرة بين البقاء مع أبيه وأمه وزوجته، ورغبته في الهجرة إلى استراليا مع شريكه وصديقه، وخاصة بعد تردِّي أوضاع مشروعهما في المقاولات، بعد ثورة يناير 2011، ويأسهما من انحراف مسار الثورة والقُوَى التي تخاطفتها، يقول: ”عاودَني الشغف القديم لكتابة القصص ونظْم القصائد، ربما كنوع من التعويض وملء الفراغ، أو كطريقة لتفريغ الشحن والتخلص من المخاوف؛ لا أعرف يقينًا” 52
3ــ
وتحت مظلَّةٍ أسطورية، يروي “السارد” حول بحْث جميع فروع العائلة عن الكنز الذي حكى عنه الشيخ، الجد الأكبر، حيث قال إنه سيأتي فرْد من العائلة اسمه محمد، وهو الذي سيجد الكنز، الذي يحرسه قرد كبير أجرب، وهو الذي سيستخرجه من بيت الخرنفش، الذي سكَنه الجد الشيخ وزوجاته الثلاث، كل واحدة منهن في جناح مع أولادها. يشرَع الكاتب الضِّمْني، في رحلة بحْث عن الجذور وشجرة العائلة، يستنهض ذاكرة آباء العائلة، ويجمع الصور، ويعيد أصوات الراحلين وقصصهم إلى الحاضر، وكلَّما استحضر قصصَهم وجمعَها؛ يزداد حَيْرة، ويظَل التساؤل مفتوحًا حتى نهاية النَّص، هل سيظهر الكنز، وهل سيبقى وسط عائلته التي تستنكر هجرته، أم يخوض رحلته التي لا يعرف لها أيَّة معالِمَ، وأين يجد كنزه هو، في الكتابة أم في الهجرة؟
وفي فصول السرد المرقَّمة دون عنوانات، يرصد الروائي حركة سَفر العائلة وتنقُّلها بين العاصمة القاهرة، وبيت البلدة الواقعة في الريف المصري، في المناسبات والأعياد، ويكشف عن الطقوس الخاصة لبعض طبقات وشرائح المجتمع المصري بريفه ومُدنه، والتي يجد القارئ فيها نفسه في تفاصيل حياة الكثير من العائلات المصرية.
وفي بعض هذه المَشاهد يجسِّد الكاتب لذَّة العطاء الإنساني الفِطري من خلال بنْية بعض شخوص الرواية؛ مثل عمَّته نعمات؛ أخت فاضل من الزوجة التركية، التي وهَبَها أبوها قطعة أرض وبيت في الريف؛ حبًّا لها وتعويضًا عن بقائها وحيدةً بعد طلاقها، وهي لم تَزَل في الثامنة عشْر من عمرها. هذه السيدة التي تكشف أفعالها عن طاقة الحب في بعض البشَر، وقُدرتهم على تهيئة حياة المجموعات من حولهم بكل مَحاوِرها، بكل تفاصيلها التي تدعم إقامة مجتمع يتمتع ببعض مقوِّمات الحياة الآدمية، كما يتحلَّى بالوعي والمعارف.
يصِف السارد حالَ نعمات في بيت الخرنفش، بعد موت أبيها، وقبْل أن تستقل في البلدة، وتبني بيتها الخاصَّ، يقول: “تعجَّبت لكون حقيبة متوسطة الحجم قد استوعبت ملابسها وحاجياتها، كأنها لم تَعِشْ ثلاثين عامًا تحت سقْف هذا البيت، لم تكن عروسًا ذات يوم، تُزف بالشيء والشويَّات؟ أدهشها خِفة وجودها في بيت أبيها منذ رحيله، أدركت أن وجوده فقط هو ما كان يمنحها الإحساس بالثقل، لمكانتها عنده، ومكانته لدى الجميع، أنها اليوم صارت تطفو فوق واقع البيت، تخدش الموجودات فلا تخلِّف أثرًا.” 111
نتمكن من أن نجد أنفسنا في بعض الأماكن، وتضيع ذواتنا في أماكن أخرى، فنصبح مجرد ظلال، ربما المكان ذاته هو ما يترك هذا الأثر، أو مَن يقطنون فيه معنا، وربما قدراتنا على التأثير في المكان، القدرة على تطويره هي ما تجذبنا لاختياره والبقاء بين جنباته. ففي الحياة أماكن تبعثرنا وأخرى تشيِّدنا..
هذا الشعور بالخفة – في بيت الخرنفش بالجمالية – هو ما جعَل نعمات تقيم بيتها الخاصَّ في البلدة، وتؤسس حوْله حياةً مكتملة، تتعدَّى احتياجاتها لاحتياجات المجتمع البسيط المحيط بها، يقول الراوي: “أمَّا نعمات فقد مضَت ترتِّب البيت وترعى شؤون البلدة والفلاحين، فأنشأت حوضًا لسقاية الدواب من الجُرن الفسيح عند مدخل البلدة، وجعلته سبيلًا ينتفع به من يَرِد البلدة دون تخصيص، كما دقَّت بجواره طرمبة المياة الحلوة؛ ليشرب منها أهل البلدة، لاحظتْ أيضًا أن الفتيات – اللاتي يساعدنها في مهام البيت من بنات الفلاحين – لا يعرفن الألِف من كوز الذرة،… فانتبهت لكون البلدة ينقصها كُتَّاب يعلِّم الصغار، وأوصت ببناء تعريشة من جذوع النخل،…، بدأت بنفْسها تعليم الصغار، … حتى أمكنها أن تستقدم شيخًا معمَّمًا من البندر” 127، 128.
وتأتي بعض المشاهد في نَص “ورثة آل الشيخ” لتفصِح عن الكثير من الغرائز البشرية، كما تشير لمكانة وأثَر السُّلطات المختلِفة في المجتمع المصري؛ يقول الراوي وهو يحكي عن انتقام الحكمدار صدقي أكبر أبناء الشيخ من زوج أخته، التي ضرَبها وطلَّقها بعد شهور من زواجه منها، يقول: “داهَم الحكمدار قصْرَ المطرية، فأوثَق حبْلًا حول رقبة زوج أخته، وأخذ يجُره حتى ساحة ترويض الخيول، هناك أمَر رجالَه بسحْب الخيل العربية من مرابطها واحدة بواحدة، وشنْقها أمام عينَيه المذعورتين، حتى أفضلها وامتطاه، وأخذ يرمح خلْف الرجُل المفجوع في خيله الأصيلة، ويسوِّطه بسوْط الركوب في كل موضع، حتى سقَط مقطوع النفس” 42.
في مشهد نفسيٍّ آخَر يستنطق الباطن الإنسانيَ وبعض عذاباته الصامتة، ويطوي شهورَ وسنواتٍ من عُمْر الشخصيات، يحكي الرواي عن شريكه وصديقه الذي يملك معه المكتبَ الهندسيَّ وشركة المقاولات، يصوِّر حاله بعد أن خرج من المعتقل بعد ثورة 25 يناير 2011، يقول: “قامت ثورة، وحلَّت لحظة جمود مشوبة بالتوتر، كأنما نترقب لِمَا ستُسفر عنه حيلة الساحر،… فقد تناوَب السَّحرة من كل فريق على تقديم الحِيَل فوق مسرح الميدان، دائبين لكي يختلفوا في كل شيء باستثناء أمْر وحيد: اللون الأحمر لمناديلهم المتطايرة مع نهاية كل فقرة. اعتُقل شريكي في ذروة فقرة من الفقرات، ولم يكن قد مَرَّ عام منذ اندلاع الثورة، فحُرمت حتى من نبؤاته قصيرة النظر. تبخَّرت أحلامنا التي حسبناها ممكِنة، وحلَّت مكانها أفكار داكنة، تكاثفت فوق رؤوسنا كسُحب مشحونة بالتهديدات، مَرَّ قرابة شهر قبْل أن أعرف مكان احتجازه، وخمسة أشهر أخرى حتى خرَج فاقدًا نصف وزْنه، وجُلَّ حماسه المعتاد للحياة، .. ليس ثمة حياة تسيل خلْف عينيه الزجاجيتين”51، 52. ونستكمل المقال القادم.