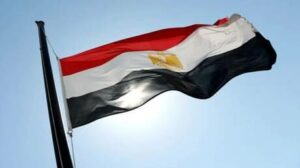بقلم دكتور / عمار علي حسن
تتنازع المصريين رؤيتان؛ الأولى ترى «مصر هبة النيل»، والثانية تراها «هبة المصريين»، لكن الحقيقة تبين أنها حصيلة الاثنتين، فأى نهر يجرى بين كسالى أو متواكلين أو لا طموح لهم أو ليست لديهم فكرة ورؤية، أو بمعنى أوسع نزوع إلى التحضر والترقى فى العيش، يمكن ألا يُحدث فارقًا كبيرًا فى حياتهم لأنهم لا يستغلون وجوده على الوجه الأمثل.
فالجيبانا، وهى أسفار مصر القديمة، تقول إن المصريين سعوا إلى النيل سعيًا فى القرون الغابرة، بعد أن وقع الجفاف فى صحراء مصر الغربية، التى كانت مروجًا خضراء، يهطل عليها المطر بغزارة، فراحوا يتنقلون وراء سبل الحياة، حتى اكتشفوا هذا النهر يجرى بين أدغال وبوص وأحراش وهيش، فشمروا عن سواعدهم، وأعملوا مناجلهم الحجرية بلا كلل ولا ملل، حتى انكشف الماء يجرى، وانبسطت الأرض اللينة، وصارت صالحة للزراعة، فَبَذروا فيها الحَب، وانتظروا الحصاد.
واستعمل المصريون النيل فى النقل النهرى الرخيص، وفى تربية الماشية والضأن ومختلف الدواب، وصيد الأسماك، وفى إمداد المدن والقرى بما تحتاجه من الماء العذب، وفى الصناعات التى تحتاج إلى المياه كعنصر أساسى فيها. وبالماء نفسه أُقيمت الحدائق فى المدن، وزُرعت الأشجار على جانبى الشوارع، التى ما إن تشب عن الطوق حتى تعتمد على نفسها فى جلب المياه إليها عبر جذورها المديدة الراسخة.
هكذا تشكل المجتمع المصرى من النيل وتشكل النيل، أو أُعيدت هندسة وظائفه الحيوية بأيدى المصريين، وصار الاثنان كلًّا فى واحد، حيث أسهم النيل فى تكوين شخصية المصرى، بعد أن انطبعت به سماتها وقسماتها، بدءًا بالنظرة إلى الذات، وانتهاءً بتصور الكون، مرورًا بالتعامل مع المجتمع العام، فالمصرى لا يبدو إلا شخصية مفطورة على الزراعة، تسربت خصائصها إلى نفسه، فعرفت أن تحصيل الماء والشراب يتطلب صبرًا ودأبًا ورجاء من الله، فالزارع يغرس غرسه ويرعاه، وينتظر الحصاد، داعيًا ربه ألا يغدر بزرعه شىء من جفاف أو ارتباك فى الرى أو آفات أو ريح صرصر عاتية.
والنيل أسهم كثيرًا فى تشكيل علاقة السلطة بالناس فى مصر، فالحكم قام منذ أول التاريخ على تنظيم الرى، ووظّف قدراته الإدارية والمعرفية فى هذا، فربط الفلاحين به، وحصل منهم على الطاعة مقابل المياه.. كما ارتبط أهل مصر جميعًا بالنهر، تبقى كثافتهم السكانية الرئيسية حوله، فسهّل هذا الوضع على الإدارة التحكم فى الناس، فالمصرى إن تمرد أو خرج على السلطة ليست أمامه غابات يختبئ فيها، ولا جبال شاهقة عامرة بالكهوف والمغارات يهرب إليها، إنما صحراء قاحلة، لا يفهم أسرارها إلا أهلها، ولا يطيق العيش فيها إلا مَن ألفوها على مدار القرون من البدو.
والنيل أسهم عميقًا فى رفد علوم المصريين، خصوصًا فى الاجتماع والجغرافيا والأنثروبولوجيا والآثار والتاريخ، بكثير من الخصائص والظواهر، فجعلوا ابتداءً تلويث المياه العذبة من الكبائر، ويشفع للمصرى يوم القيامة أنه لم يلوث النهر، ونشأت الدراسات الريفية، واقتصاديات الزراعة، وجغرافيا الموارد الطبيعية والبشرية، ووجدت العلوم السياسية فرصة للحديث عن «سمات المجتمع النهرى» و«الدولة المركزية» و«شرعية السلطة»، تثبت كثيرًا حين تعتنى بالنهر أو تحافظ عليه أو تحسن توزيع مياهه على المزارعين، وعلى محتاجى المياه فى الأغراض المنزلية فى المدن والقرى. ووجد علماء الاجتماع موضوعات للبحث حين أمعنوا النظر فى تعاون الفلاحين فى الرى، وفى مواسم الزراعة والحصاد، واستعمالهم الماء فى إطفاء الحرائق التى تنشب بين حين وآخر، وأيام كانوا يتراصون فى شجاعة لمواجهة الفيضان قبل إنشاء السد العالى.
وحدد النيل أماكن وجود آثار المصريين القدماء وكنوزهم، فمدنهم وقراهم كانت على ضفافه، وإن كانت وقتها غير ما هى عليه الآن، وغربه فى الصحراء القريبة كانوا يدفنون موتاهم، وفى بعض شرقه أيضًا كما نرى فى تل العمارنة وطنها الجبل وصان الحجر، وفى قلبه أحيانًا مثلما نرى فى آثار منف. وأهرامات الجيزة الثلاثة يُقال إن النيل كان طيّعًا فى نقل الأحجار الضخمة التى تراصت لتصنع هذه المعجزة المبهرة.. لهذا تهتدى البعثات الأثرية بالنيل فى بحثها عن المدفون والمطمور تحت الأرض من مدن وقرى ومقابر قديمة، ولا يمضى عام إلا وتعثر على جديد.
وأمد النيل ذائقة المصريين الفنية بكثير من القيم والصور والمعانى، ففيه أنشدوا الأشعار مثل رائعة محمود حسين إسماعيل «النهر الخالد»، ومنه صدحوا بالموسيقى والأغانى مثل: «شمس الأصيل» لأم كلثوم، و«يا تبر سايل بين شطين» لعبدالحليم حافظ، وكتبوا القصص والروايات والمسرحيات، فنرى على سبيل المثال لا الحصر طه حسين يكتب «ما وراء النهر»، ونجيب محفوظ يكتب «ثرثرة فوق النيل»، ويكتب عبدالرحمن الشرقاوى «الأرض»، ويكتب يوسف إدريس «الحرام»، ويكتب عبدالله الطوخى «رباعية النهر»، ويكتب عبدالله الهادى «البحارى»، وتكتب جاذبية صدقى «ابن النيل»، ويكتب إبراهيم فهمى «العشق أوله القرى»، وتأتى السينما لنرى أفلامًا مثل: «صراع فى الوادى» و«دماء فى النيل» و«العوامة ٧٠» و«المراكبى».. إلخ.
ومع النيل، أنتجت قرائح المصريين الأمثال والحكم والسير والأساطير والأغانى والألعاب الشعبية. كما أن كثيرًا من الحكايات والذكريات التى تُستعاد فى ليالى السمر تأتى على ذكر قصة كل منهم مع النيل، ابن القرية الذى سبح فيه أو اصطاد منه، أو كانت له ساعات شقاء مع وسائل الرى القديمة مثل الطنبور والشادوف، وابن المدينة، الذى لا يزال يرى أن السكنى على ضفتى النيل غاية عظيمة، ومقصد يستحق السعى والفخر، ويرى أن التنزه على كورنيشه فرصة طيبة للترويح عن النفس، وأن لقاء المحبوب أمام مياهه السارية الجارية كان أمرًا مختلفًا.
هكذا صارت شخصية مصر، وفق تعبير جمال حمدان، مسكونة بالنيل، فإن غفلوا عنه، فتلك مشكلة ومأساة.. فالشعب المصرى هو الباقى إلى قيام الساعة، وبقاؤه مرهون فى جانب كبير منه باستمرار تدفق مياه النيل، لهذا يجب أن يكون يقظًا، مدركًا أن حياته لا يمكن لها أن تستقيم أو تستمر إن غاب النيل أو نقص أو جف، لا قدّر الله.