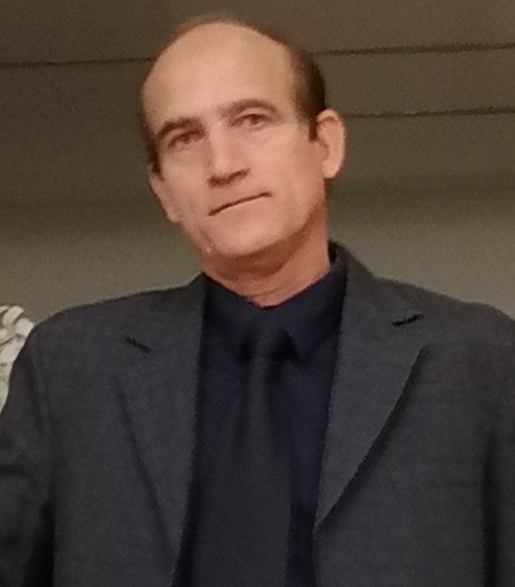بقلم / روعة محسن الدندن
ليس هناك من ناقد يمتلك مفاتيح أسرار القصيدة ويعرف اللغز غير صاحبها ويمكنه أن يوجه بوصلته لكشف حقيقة مابين السطور ويأخذك معه حيث يريد ومع ذلك نصف الحقيقة تبقى سرا ومن ينتقدها سواه يفسر النصف ويبقى النصف بينه وبين الشاعر مجهولاً أيضا
بدأ شاعرنا وكأنه يوضح لنا أو يفسر ذهوله عن تلك الأنثى المذهلة وحاله ليس كحال القدماء من الشعراء الذين تغزلوا بمحبوباتهم أو بالنساء دون كل أدوات الفتنة في عصرنا (رغم عشق النساء للتجميل بما هو متاح ببيئتها وبإمكاناتها)
وهذا ما جعلهم أكثر ضعفا أمام الجمال ولو كان جمالاً بسبب أدوات الزينة ورغم معرفتهم بأن هذا فيه من التصنع الكثير ولكن الرجل بطبعه يعشق الجمال ولذلك سعى أحدهم لإختراع أدوات التجميل فلا يحتاج شاعرنا للكثير من الوقت ليحيك قصيدته وكأنه يردها شالا يضعه على كتفيها ويقدمها هديها فيكون وبعد أن انتهى من تقديم هديته عاد لقصيدته وكأنه يخبرها ويخبرنا بأنها أجمل النساء وأنه يراها بين الكلمات وهذه الفتنة لا يقاومها إنس ولا جان.
وأود الإشارة لنقطة والتي لم يغفل شاعرنا عنها بأنه لم يخاطبها بالحبيبة ولا العشيقة وإنما وصفها بالقصيدة وبالنقد بلفظ ساحرتي ومولاتي ولكن كلاهما ماكر ومراوغ سلكا طريق الغواية بفطرته التي خلقه الله عليها
فكل منهما يعرف نقطة ضعف الطرف الآخر فالأنثى بطبيعتها تعشق الكلام الجميل والغزل وتحب أن يخلدها شاعرها بقصيدة مختومة لها وهذا ما شجعه على الاسترسال في الكتابة
وهي بخبثها ومكرها تعلم أن الجمال والدلال لا يقاومه الرجال
ونكسب نحن الاستمتاع بقصيدة غزلية بين العاشق والمعشوق ولحظة مكاشفة نقدية لما تمثله هذه القصيدة له
وأجزم أن السبب صاحبتها كمن يطرق في كل مرة الباب لتفتح له
( أرى أنه وحتى تكون الرؤية النقدية شافية كافية من الضروري الإشارة لإثارة القارئ وتشويقه وتحفيزه لتوقع النتيجة حيث بدأت القصيدة بالإثارة ثم بموقف المجتمع والفتاوى من العاشقين ثم الميل للنزعة التعبيرية الصوفية ثم ختام القصيدة ببيت أظن أن الشاعر أراد به أن يكون بيتا متفردا في تعبيره ربما تناولته الوساط والأجيال لأنه جعل أفق التوقع لدى القارئ أبعد مما كان يتوقع)
روعة محسن الدندن
قراءة نقدية ذاتية لقصيدتي بعنوان “المذهلة”
ليس هناك من يشك في أن النساء هنَّ بساتين الحياة وأزاهيرها، وفيهنَّ المتعة الوحيدة المُتبقية لفقراء ومساكين الرجال؛ حين تختفي باقي وسائل الإمتاع المتمثلة في الجاه والمال والسلطان، وربما جعلهن الله كذلك ليتمتع بجمالهن وفتنتهن التعساء من الرجال البؤساء أمثالي؛ وربما هذا ما جعل الواعظين يحذرون المؤمنين دائمًا من فتنتهنَّ وغوايتهن حتى وصل الأمر بالتخويف إلى القول بأنهن أخوات الشياطين، وبأن معظم أهل النار من النساء (هكذا يقول البعض منهم)، وقليلا ما يتذكرون قول رسولنا الكريم “رفقا بالقوارير”.
ومن العبث هنا أن ننشغل بوصف جماليات المرأة لأن ذلك يحتاج كتابا وليس صفحة أو صفحتين، ونفس الشيء ينطبق على مكرهنَّ وبلاويهن التي تحتاج موسوعات لتدوينها، وبالتأكيد كان هذا هو ما دفع شعراءنا القدامى إلى التفنن في إبراز جمال النساء وفتنتهن، وهم (أي الشعراء) كانوا يُولدون ويعيشون في بيئة صحراوية جافة خالية من مظاهر الجمال والخيال فاهتدى بعضهم أو جُلهم إلى وصف النساء بالبدر أحيانا، أو بالقمر أحيانا أخرى ( وهذا أضعف الإيمان)، أما في عصرنا وقد اخترع الإنسان ـ أو لعلنا قلنا الرجال ـ العديد من وسائل التجميل التي تزيد الفاتنات فتنة، وعطرًا، وتزيد عيونهن جبروتًا وسحرا، هذا إضافة لمصممي الأزياء الذين اخترعوا تصميمات لفساتينهن التى لا تحتاج أكثر من مترٍ من القماش يكفي فقط لستر مراكز الخطر وإخفاء أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها الإناث ويمكنهن بها تدمير كل وسائل مقاومة الرجال، وحرصا منا على اتباع المواعظ فسنتكلم هنا عن العيون وسحرها بقصيدة “المذهلة” ل “يوسف أبو شادي” الذي أراد أن ينقد قصيدته نقدا ذاتياً وموضوعياً قدر الإمكان ومحاكمة قلمه من حيث تحقيق أهداف الشعر لدى المتلقي والمُتمثلة في الإثارة والتشويق والمتعة وتحفيز خاصية التوقع لديه لنراه قد تعجل إثارة المتلقي فى استهلال قصيدته بمشهد سينمائي يحفز القارئ تلقائياً لاسترجاع نفس المشهد من عقله الباطن، والذي رآه مصورًا في أذهانهم منذ آلاف السنين بين فرعون وموسى عليه السلام حيث استهل قصيدته بمعركة مثيرة بين فرعون العصر الحديث وأنثاه التي تجملت وتعطرت لنرى أن معركته مع الأنثى قد انتهت قبل أن تبدأ حيث قال:
عيناها سَحَرَتْ فِرْعونًا
فأتى بالسَّحرَةِ دونَ عددْ
وإذا بالسَّحرَةِ قد سجدوا
والبدرُ لحُورِ العينِ سجدْ
وقبل أن نغوص بالرؤية النقدية الذاتية، يجدر بنا هنا أن نذكر ملاحظتنا الأولية على أسلوب أبي شادي الذي يحاول دائما أن يبني قصيدته على عدة مشاهد سينيمائية أحيانا، وأحيانا مسرحية؛ إيمانا منه أن على الشاعر أن يكون مُصوِّرًا، ومخرجًا سينيمائياً، ونحاتًا، ورسامًا ومُلوِّنًا، وعازفًا على أوتار وجدان المُتلقي، ليجعل من قصيدته فيلمًا أو لوحة تشكيلية متعددة المناظر والمشاهد والألوان.
ثم ننتقل إلى الجزء التالي من القصيدة التي لم يكتف بها كما يبدو بهزيمة فرعون وسحرته بل إن سحر جمال مذهلته قد انتقل للبدر والجن والأسد حيث يقول:
مُذهلةٌ تَخْطفُ أبْصارًا
من عينِ البدرِ وعينِ الجنِّ وعينِ أَسَدْ
إن نَظَرَ البدرُ لخدَّيها
ستراهُ لوردِ الخدِّ حَسَدْ
أو نَظَرَ الجنُّ لعينيها
ستراهُ على الإبداعِ حقدْ
والأسدُ تراهُ غدا عُصفورًا
في مِحرابِ الحُسنِ رَقَدْ
وهنا ينبري المدافعون عن الدين والموكلون بمحاربة المعاصي ليحولوا أوراق الشاعر إلى المفتي بغرض الحصول على فتوى بتكفيره؛ ومن ثم قتله فينتقل إلى مشهد آخر يقول فيه:
ولقالَ المُفتي إنْ سألوهُ
عن المفتونِ بِحُبِّ جَسَدْ
مَغْفورٌ ذَنْبُكِ سيِّدتي
إنْ كان جمالُكِ حُجَّةَ مَنْ
لجمالِ اللهِ هوى وَعبَدْ
وهنا يعتز ويغتر الشاعر ببراءته فيدعي البطولة قائلا لفاتنته ومذهلته:
قسمًا بالمولى سيِّدَتي
والشَّاعِرُ قولَ الصِّدْقِ عَمَدْ
لو أفتى الشَّيخُ بتكفيري
وعليَّ أميرُ الشِّعرِ شَهَدْ
أو قالَ المفتي: زنديقٌ
أو قالَ النَّاسُ عليَّ لَحَدْ
سأقولُ كذبتمْ .. وظلمتمْ
وإذا عُذِّبتُ أقولُ “أَحَدْ”
فأقامَ الصُّوفيَّةُ ذِكرًا
وأتى الحلاجُ يقولُ مَدَددددددددددْ
ثم ينتهز الشاعر شعوره بجرأته وبطولته فيتشجع لمخاطبة مذهلته بلهجة صوفية تذكَّرَها مع ذكره للحلاج فيقول:
وكتبتُ إليها أن ترحمْ
متبولًا هامَ على عرفاتِ
وقد وجدوهُ جوارَ “أُحدْ”
وحبيبًا يدعو للرَّحمنِ
وقُبلَ بلوغِ دُعاهُ حَمَدْ
ويبدو أنها قد تذكرت أنوثتها وعشقها لتلويع وتتبيل قلوب عاشقيها فتجاهلت طلبه بالرحمة منها والشفقة عليه فانتقل إلى المحاولة التي تعشقها الإناث؛ مصرًا على تحفيزها للعناية بطلبه الرحمة فقال:
أرسلتُ إليها إكْليلاً
والرَّاسلُ مَنْ بالحُبِّ سَهَدْ
وهنا تأكد من نجاح المحاولة حين جاءه ردها قائلة:
قالتْ: فلْتكْتُبْ لي بيتًا
يُغْرِيني لم يكتبْهُ أَحَدْ
ولعلنا هنا نستكشف واحدة من خصال الرجل الشرقي الذي يعد حبيبته أن يأتي لها بقطعة من السماء إن هي تعطفت عليه، وحين تتعطف عليه يتعلل بفشله في تنفيذ وعده لأمر خارج عن إرادته، وحين تخلعه يحاول نفس المحاولة وبنفس الأسلوب مع أنثى أخرى. ولأنه كان على ثقة أنه ليس هناك شاعر يستطيع إغراء هذه المذهلة فتحجج لها عن عدم مقدرته لكتابة ذلك البيت قائلًا:
فأجبتُ: الوحيُ يُعانِدُني
وأجابتْ: بلْ “مَنْ جدَّ وَجَدْ”
وهنا لم يجد مفر من الاستجابة لطلبها سوى أن ينشد قائلا:
قسمًا بالمولى ساحرتي
ـ واللهُ على النِّياتِ وَعَدْ ـ
لو أنَّ اللهَ أشارَ إلى
إبليسَ عليِكِ لكانَ سَجَدْ
وكما استحضر يوسف أبو شادى في بداية قصيدته قصة سيدنا موسى عليه السلام وعصاه السحرية، وفرعون وسحرته الذين سجدوا وآمنوا بموسى، فإنه وهنا ينهي قصيدته بمشهد عصيان إبليس أمر الله للسجود لآدم إجلالاً لإبداع الله في خلقه، إلا أنه عاد ليطيع الله مفتونا ومذهولا بجمال حواء بعد الترقي بما حققه الإنسان من تطور فى الارتقاء بفكره وعقله ومظهره وسلوكياته وخصاله الحميدة.
وإصرارًا من يوسف أبو شادي على مضاعفة شعور المتلقي بالإثارة والمتعة وتحفيزه على إطلاق العنان لأفق توقعاته؛ ترك النهاية منفتحة على كل الاحتمالات التي يتوقعها القارئ؛ إذ إنه لم يبين عما إذا كان الشاعر قد نجح في كتابة البيت الشعري الذي يُغري ويفتن أنثاه، أم أنه فشل في إرضاء غرورها، وربما توقع آخر أنها وما دامت صمتت بعد سماعها البيت، وكما نقول ب “أن السكوت علامة الرضا” فمعناها أن ربنا تمم ليوسف أبو شادي ومذهلته بخير وتزوجا، وسيقول ثالث: بل ربما كانت تتلاعب فقط بمشاعره وأرادت فقك استفزازه ليكتب لها شعرًا تتباهي به بين المحيطين والمحيطات بها لأنها جميلة ساحرة وماكرة وربما كان سجود إبليس لها اعترافًا منه بأنها أستاذته في المكر والغواية.
وهنا أكون قد انتهيت من قراءتي النقدية الذاتية لقصيدتي “المذهلة” والتي أصدرتها بديوان يحمل نفس الاسم، ولم يتبق لي هنا سوى أني أفتح الباب على مصراعية لمن أراد أن ينبري “لنقد النقد” سواء كان قارئا عاديا، أو ضمنياً، أو ناقدًا.