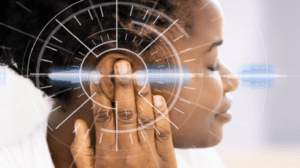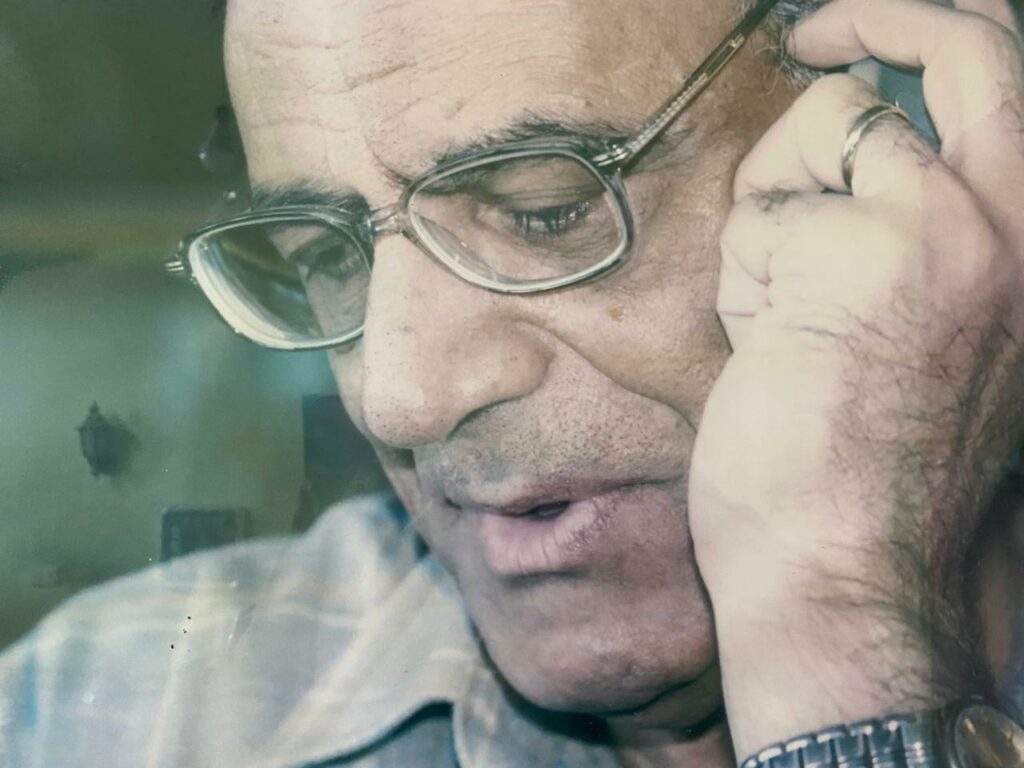بقلم دكتورة / أماني فؤاد
في إحدى وحدات تلقِّي حالات النساء المعنَّفات والاستماع لمآسيهن، جاءتهم حالة لسيدة أصرَّ زوجها أن يتم ختانها، بعد أن تخطت سِن السابعة والعشرين؛ لأنه سيسافر ليعمل بالخارج، ولا يريد أن يتركها طبيعية، في مثل هذه الحالات التي يتكرر استقبالها في الوحدة، بحسب المختصين، يظهر ملمحان أساسيان ضمْن حقائق مؤسفة، أولا: عدم وعي بعض الرجال بأنه لا علاقة مباشرة بين العفاف وبتْر طبيعة الخِلقة، كأن بعضهم لا يدرك أن منظومة القِيَم هي التي تسيطر على الغرائز والاحتياجات، وأن إعلاء القِيَم وتربيتها هو الذي ينظِّم الشهوات، كما أن الالتزام بالعهود مفهوم أخلاقي كامن في النفس، لا علاقة له بأجزاء من الجسد. الملمح الثاني تساؤل يَرِد على الخاطر: لماذا انشغل الرجُل بتأمين ما يتصور امتلاكه من الجانب الجسدي في العلاقة، وهل تراه فكَّر في الـتأثيرات النفسية للغربة على طرفَي الزواج، عليه وعلى شريكة حياته، كأننا – ونحن نواجه هذه المواقف – في حاجة ماسة للمعرفة، والوعي بأبعاد المشكلات النفسية والاجتماعية، في حاجة للعلم والتعليم الحقيقي والثقافة، والنظر إلى الطرف الآخَر في العلاقة، ليس فقط الحرص على عدم إيذائه النفسي أو المادي، بل البحث عن سعادته بفهمه، والتواصُل المُحب معه.
ولقد وردت لديهم حالة لطبيب نفسي، يعمل ويعيش في انجلترا، عقَد قرانه على طبيبة من القاهرة، بعد أن أصر على أن تترك عمَلها، وترتدي النقاب؛ لتسافر معه، وبالفعل قامت بما أراد، ربما استجابت كما تفعل النساء الآن لمجرد الحصول على فرصة زواج، تفاقمت الخلافات بينهما قبْل إتمام الزواج، كان ينتقد ويقلل من شأن كل ما تقوم به، ويشكك في كل تصرُّف يصدر عنها، فطلَّقها لمجرد أنها تأخرت للثانية عشر ليلًا مع صديقتها، لم يدرك هذا الطبيب المتعلم – الذي يعيش في الخارج – أهمية التفاهمات التي تضمَن تواصُلًا يعبِّر فيه الطرفان عن نفسَيهما، والظروف التي يتعرضان لها، وتحيط بهما، أراد أن يأمُر فلا يجد سوى الطاعة والاستجابة، أراد أن يسْخر ويقلل من قيمة الإنسانة التي سيتزوجها وعملها؛ ليشعرها بتفوقه وسيادته، وضرورة طاعته، وربما نتساءل هنا: ألم يترك تعليمه وسفَره للخارج ومعايشته لثقافات حرة، وتخصصُه النفسي أيَّ أثَر على وعيه وثقافته، ومرونة الشخصية، والارتقاء بالسلوك؟ كأن التعليم بمفرده لا يكفي. فكثير من المتعلمين الحاصلين على درجة الدكتوراة – ومن الذين احتكوا بثقافة مغايرة – يرفض تمامًا عمل امرأته، أو استكمال دراستها، أو استقلالها المادي، أو مجرد ترْك بعض الأموال معها، هؤلاء النماذج يصعب عليهم تصوُّر أن للمرأة كيانًا حُرًّا، كيان يختار ويقرر، وقادر على الحياة بذاته.
كأن نوعية ما يدرَّس في المدارس، وما يعرَض في الإعلام والفنون والسرديات والدراما، وأيضًا ما يتداوله الناس فيما بينهم من أمثال ومقولات وحكايات، لا يكوّن وعيًا حقيقيًّا بمفاهيم حرية المرأة، واحترام كيانها وإرادتها واختياراتها، سواء في ظِل الأُسرة “الأب والأم”، أو في المفاهيم المؤسسة للحياة الزوجية.
كما ترد في هذه الوحدة حالات بلا حصْر لنساء تشتكي في القُرى والمدن الصغيرة من التقتير الشديد من الأزواج عليهن، وهُن في الغالب لا يعملن؛ أي لا يمتلكن دخْلًا خاصًّا بهن، كما يُلزِمهن الرجال بخدمة أهل الزوج؛ أمه وأبيه وإخوته، وإن اعترضت؛ يتم ممارسة كل أشكال العنف ضدها، والتي قد تصل لسَبِّها وضرْبها ومنْع الطعام عنها. في المجتع الريفي والطبقة الدنيا عادة يستسهل بعض الرجال إهانة المرأة، وتسخيرها لممارسة الخدمة في الأرض الزراعية أو البيوت، هي ملزَمة فقط بإطاعة أوامر زوجها، مهما طلَب منها، وهنا يجب أن نتوقف لنقول إننا في حاجة ماسة لتطوير محتوى ومضامين المناهج التي تدرَّس في مدارسنا وتخص المرأة والمجتمع،


وفي إحدى حالات تعدُّد الزوجات، التي تتكرر قصصها بحسب اختلاف الظروف الفردية والإنسانية، ذكرت إحدى النساء، المتزوجة من أحد مُلاك الأرض في المجتمع الريفي، إنها عندما لم تنجب من زوجها؛ تزوَّج سبْع نساء على التوالي، فكلَّما مَرَّ عامان ولم تَظهَر علامات الحمْل على الزوجة؛ طلَّقها، ولأن زوجته الأولى هي التي طلبت الطلاق؛ حبَسها في غرفتها بمنزله، وحرَمها من زيارة أهلها أو اتصالهم بها. لم يتفهم الرجُّل إنها كيان بشري لا يحتمل هذا التعدد، وألحقَ بها الأذى النفسي، فادَّعى أنها تعترض على شرْع الله، بينما كل ما أرادته تسريحًا بإحسان؛ أليس هذا أيضًا كلام الله ورسوله؟!
وجاءت – في إحدى الحالات التي تواصلت مع الوحدة – امرأة تشتكي من سفَر زوجها المستمر، وتزوُّجِه من فلبينية، في البلد التي يعمل بها، وأنه يقَتِّر عليها وعلى أولادها في متطلبات الحياة، فإذا بهم يكتشفون – بعد الاستماع للزوج – أنها هي من ترفض السفَر، وتواعِد رجُلًا آخَرَ، وأنها تكذب بخصوص إنفاقه عليها وعلى أولادهما، ويقول المسئولون إنها لم تنطق عندما سمعت من زوجها هذه المواجهات، واتضح كذبها، لم تَعِ هذه المرأة إنها بصَوْن نفسها وأُسرتها تحافظ على كيانها قبل أن تفكر في الانتقام من زوج غائب.
كما تكثُر حالات السيدات اللاتي يأتين ليشتكين من أزمة الافتقار للرجولة، وأن الرجُل لم يعد مسئولًا عن حياة الأُسرة ولا متطلباتها، ويركن سريعًا للدعة والكسل؛ فيترك زوجته تعمل وتعيل نفسها وأولادها، وحين يجد الرجُل هذه المرأة؛ يلقي عليها بكل مسئوليات وشئون الأُسرة، وتتبدد النخوة والشهامة وإعالة الأُسرة أمام شاشة البلايستيشن، أو المخدرات وجلسات القهوة والأصدقاء، لتُطحن المرأة بتحمُّل مسئوليات بيت بأكمله، بجوار عملها الذي يعيش عليه الجميع.
حين شرعتُ أكتب عن موضوع الطلاق في مصر؛ اتضح لي أن هذه القضية شديدة الاتساع، وأنها تتضمن محاوِرَ متعددةً ومستوياتٍ كثيرةً مختلفة، وهو ما سأتناوله في سلسلة من المقالات، وتختلف أسباب الطلاق في كل مستوى عن المستوى الآخَر، لكن أسباب كل هذه المستويات باختلافاتها تتشابه أيضًا، وتُسفِر في النهاية عن وقوع الطلاق.
هذا وتختلف أسباب الطلاق بين كبار السن عن أسباب حديثي الزواج، والأجيال الأكثر حداثة عمرية، كما تختلف أيضًا أسباب الطلاق بين الطبقات؛ فالطبقة الفقيرة والوسطى الدنيا، تختلف في أسبابها ونوعية مشكلاتها عن الوسطى العليا والطبقة العليا، التي تقبض على أغلب رأس المال.
ولقد لاحظتُ – أثناء البحث في هذه المستويات – أن هناك قاسِمًا مشترَكًا أعلى بين الشرائح كافة، وهو الذي يؤدِّي بالجميع إلى هذا المصير الانفصالي، الذي يشتت أُسَرًا بأكملها، ويعبث بنَشْء المستقبل، حيث يبرز بشدة الافتقار إلى الوعي الإنساني المعتدل، الذي يتكوَّن بالتعلم والثقافة والفنون والتفكر والاعتدال الديني، بمعرفة الحقوق والواجبات سواء للزوج أو الزوجة، كما رصدت عدم توافر قدْر من الإنسانية، التي توفِّر المحبة والتسامح في التعاملات، كما يسود المجتمع الجهل وعدم المعرفة بحدود الذات وحقوقها، على ألا تتغول على حقوق الطرف الآخَر، وألا يمارس إرهابه عليه، كما أذهلني غياب دور الأُسرة وقِيَمها، وهذا إمَّا لانشغال الأب والأم في طاحونة من العمل المستمر، أو لرفْض الشباب تدخُّل أيِّ طرف للإصلاح بين الطرفين عند احتمالية أو مناقشة ملابسات الطلاق. فالأُسرة – بما كان يسودها من جَوِّ الأُلفة والاحترام بين أفرادها – كانت تربِّي وتعلِّم؛ فتنشأ الذوات السوية التي تسعى للمثابرة من أجْل النجاح، الشخصيات التي تكره الفشل؛ فتجاهد لتلافي أسبابه، الكيانات التي تحب ذواتها والآخَرين، وتحتفي بالنجاح، تقوِّم أسباب الفشل، وتشتغل على تلافيها، ولا تيأس؛ فتحاول مِرارًا دون الركون لهروب سريع، وترْك العلاقة كأكوام من هَدَدٍ لا يمكن بناؤه ثانية. وأحسب أن وراء غياب الوعي هذا مجموعةً من الأسباب، أوَّلها وأهمها غياب منظومة تعليم حقيقية بمناهج إنسانية تُعلي قِيَم الاحترام والتقدير والشراكة بين الزوجَين.
كما رصدتُ ازدياد الأنانية والتفكير في الأنا فقط؛ أنا من أقول، وأنا من يفعل، أنا من ينفق، أنا من يقرر، أنا من يحدد، هذا مع عدم الوعي ولا الانتباه لمفهوم الـ”نحن”. شحَّت الرجولة، وتقلصت كقيمة أمان وسند واحتواء تسعى إليها المرأة، وتم قلْب الأدوار، فلم يعُد الرجُل يتحمل المسئولية، ولا الاجتهاد في سبيل إنجاح وإسعاد حياة الزوجية، كما شحَّت الأنوثة أيضًا، وتم تصدير المرأة القوية المعتمدة على نفسها في واجهة المشهد العام للعلاقات الاجتماعية.
تبدَّدت أيضًا أدوار الأمومة والأبوة، حيث لم يعد كيان الأُسرة حاضرًا وراسخًا في الأولاد، فإما أن قطبَي الأُسرة في الخارج للعمل وتوفير متطلبات أُسرية لا تنتهي، ولا يمكن أن تنتهي، أو رفْض الأولاد لتدخُّل أيِّ شخصية في مسار حياتهم، حتى لو كانوا آباءهم، فعادة صار البعض من الطبقة العليا والوسطى يلجئون للمتحدث المتخصص في علم النفس، وهو ما يُدخِلهم في دوامات من الصراعات النفسية والحكم الجائر على الآخَرين، وتوهم أن الجميع مرضى بشكل ما. ونتابع.